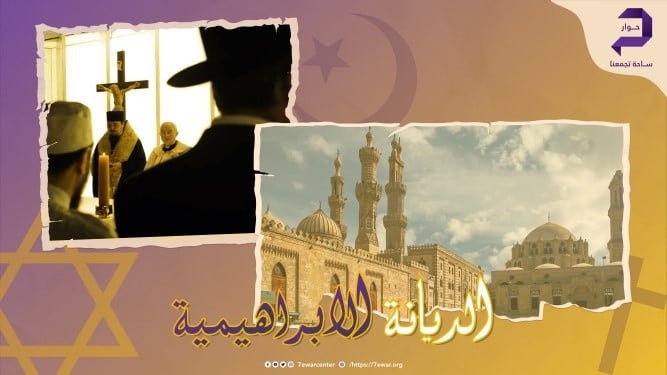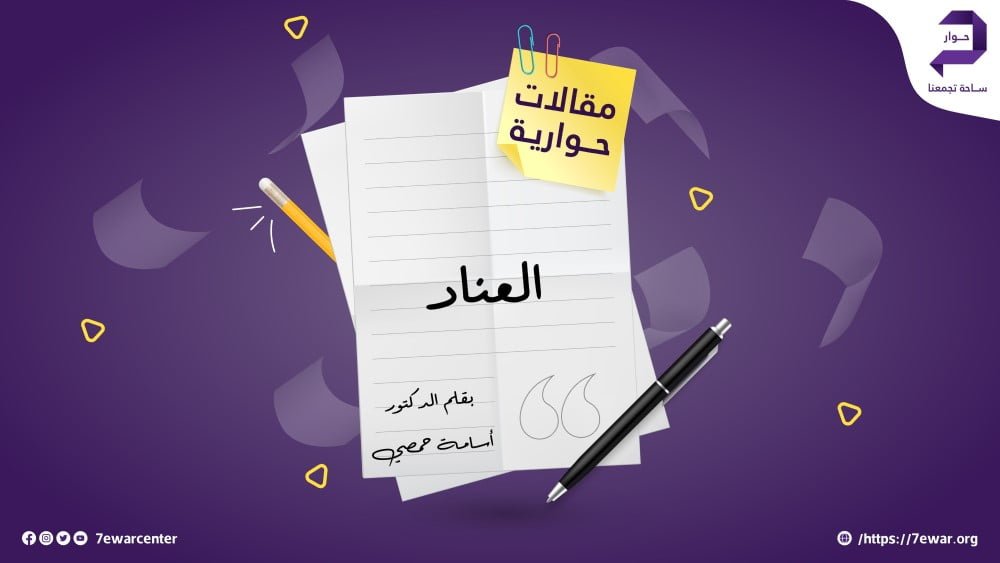الإسلام والتطرف
الإسلام والتطرف
لم يأتِ الإسلام بمثالياتٍ طوباوية لا يمكن لها أن تتحقَّق إلَّا في الخيالات، بل أتى بمنهجٍ قادرٍ على تحقيق التّوازن في الحياة البشرية الواقعيّة، فنجده في معارك الدفاع عن الثوابت والعقائد حاضراً بقوّةٍ تُرهب عدوَّ الله وعدوَّ الإنسانية، ونجدُه في وجدانيات الحبّ والتصوف، وأخلاقيات العفو والصفح حاضراً أيضاً وبنفس القوّة، ونجده في ميادين الفكر والعلم والرؤية المقاصدية الواعية حاضراً بالاندفاع ذاته.
فالإسلام هو ذلك المزيج المتناغم من الجهاد والتّصوّف والحبّ والأخلاق والفكر والعلم، ويبدأ التطرف فيه عندما يختارُ العقل أو القلب لوناً واحداً من هذا المزيج، ويجعلُه اللونَ الغالبَ عليه، فتارةً تجدُ من يجعلُه حاملاً للبندقية لا يضعها، وتارةً تجد من يجعلُه حبيس الروحانيات والوجدانيات منعزلاً عن واقعية الحياة، وتارةً تجدُ من يجعله منظومةً من الثّوابت العقلية والحجج الفكرية الخاليةِ من الواقعية والعاطفة.
إذن فالوسطيُّ هو من أدرك هذا المزيج وأحسنَ إظهاره والتعامل معه بشكلٍ متوازن، والمتطرّف هو من رأى منه وجهاً واحداً وحمل الناس عليه.
لماذا دخل التطرّف إلى الإسلام وهو الدِّين المُنزل من عند الله؟
التطرّف في حقيقته ليس ديناً، وليس شكلاً من أشكال الدِّين، بل هو شكلٌ من أشكال النّفس الإنسانية، فالإنسان المتطرِّف هو الذي يحمل رؤيةً متطرِّفةً للحياة، سواء كان متديِّناً بأيِّ دينٍ من الأديان، أو غير متديّن.
لذلك نجد في حياتنا ملحدينَ متطرفين، ومسيحينَ متطرفين، ويهوداً ومسلمين وهندوساً وبوذيين وسياسيين وعسكريين وعلماء، ومفكرين، وفنانين . . . إلخ
إنَّ أشكال التطرّف تشمل كلَّ نواحي الحياة، لكنَّ عين الإعلام المتطرّف لا ترى إلَّا شكلاً واحداً من أشكال التطرُّف، وتعمل على ترسيخ صورته في خيالات الناس وأذهانهم، فصورةُ الإنسان المتطرّف المصنوعةُ إعلامياً في عقول الناس اليوم هي صورة رجل يلبس لباساً طويلاً، ويُطلق لحيته، عبوس الوجه، مقطّب الحاجبين، لا يتكلّم إلا بالعربيَّة الفصحى، يحبُّ القتل وقطع الرؤوس، ويحتقر النساء، ويقول: الله أكبر، بينما ذلك الأشقر الذي يرتدي ربطة عنق، ويحلق لحيته، ويشرب البيرة، لا يمكن أن يكون متطرِّفاً، حتى لو أنَّه ألقى قنبلتين نوويتين على أطفالٍ ونساءٍ وشيوخٍ وشبابٍ ورجال، ولو دَمّر مدناً عن آخرها، وحتى لو أنَّه قتل أمّةً كاملةً من الهنود الحمر وأخذ أرضهم وخيراتِهم، وحتّى لو أنَّه يشعل الحروب هنا وهناك في العالم ويمدُّها بالصواريخ الذكية، والقنابل المدمّرة، وحتَّى لو كان يقتات على امتصاص اقتصادات القارّة الإفريقية، أو كان يحتكر تكنولوجيا العلاج والدّواء ويبيعها بأغلى الأثمان، أو كان يدير الانقلابات الدموية هنا وهناك تحقيقاً لمصالح الشركات العابرة للقارّات.
فخطر أكبر تنظيمٍ جهاديٍّ متطرّفٍ عرفه التاريخ الحديث وأثره لا يُعادل جزءاً بسيطاً من خطر السلوك الأمريكي الأوروبي الهمجي في السيطرة على موارد الطاقة، وطرق التجارة، وخيرات الشعوب، ورغم ذلك، ونتيجةً للتهجين الإعلامي للعقول، لا يَرى الكثير من أصحاب الوعي المستورد التطرّفَ إلَّا بشكلٍ إسلامي.
ربما يُعتبر الإسلام الدِّين الوحيد في العالم الذي فيه تشريع الجهاد (بالمعنى القتالي)، ألا يدلُّ هذا على أيديولوجيا متطرِّفة؟
يمكننا أن نقول أنَّ الإسلام هو الدّين الوحيد في العالم الذي وضع تشريعاتٍ وقوانين تنظّم الأعمال القتالية، وتضبطها عن الظلم والتعدّي والإيذاء، كتحريم قتل من لا يقاتل، أو قطع الأشجار، أو إيذاء المتعبّدين في معابدهم، أو إيذاء المعابد نفسها، ويحرِّم استعمال القنابل النووية واللاتمييزية في القتل، إلى غير ذلك من التّشريعات والضَّوابط التي تدلُّ على واقعيةٍ تشريعيةٍ وفكريّةٍ تحفظ للناس قوَّتهم في مواجهة أعدائهم، وتضبط هذه المواجهات بحدودٍ ناظمة.
فوجود ضوابط للعمل القتالي يدلُّ على رقيٍّ تشريعيٍّ كانت تغفل عنه القوانين الوضعية، بل إنَّ الإسلام قد جعل الانضباط بالضوابط الإنسانية في الأعمال الحربية والقتالية جزءاً من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، قبل أن يجعله قانوناً يتجاوزه الأقوياء، ويتجاهله الظالمون.
وهذه الضوابط التي شرّعها الإسلام للأعمال القتالية لم تستطع أن تلتزم بجزءٍ بسيطٍ منها جيوش المتقاتلين العلمانيين في الحربين العالميتين ذاتي أكبر عدد من الضحايا عبر التاريخ الإنساني، ولو أنَّها التزمت بها لكسبت الإنسانية أرواحاً كثيرةً بريئةً ما كان يجب لها أن تُزهق.
إذا كان التطرّف حالةً من حالات النفس أو العقل الإنساني، فلماذا لا يكون الإسلام علاجاً للتطرّف، بحيث لا يظهر بين المسلمين أناسٌ متطرِّفون؟
الإسلام هو المنهج الربّاني الوحيد القادر على تحقيق حالة التوازن والوسطية للأفراد والمجتمعات والأمم، وهو العلاج الأنسب في مواجهة الأفكار المتطرِّفة، وهذا الادِّعاء لا يعني عدم ظهور متطرِّفين مسلمين، فمخالفة الإنسان لضوابط المنهج، وتجاوزه لحدوده يؤدِّي به إلى الابتعاد عن وسطيَّته، وهذا الأمر ينطبق على جميع ضوابط الشرع الإسلامي وليس على قضية التطرف فقط، ولا يوجد في الإسلام شخصٌ منضبطٌ بضوابطه، وملتزمٌ بحدوده، إلَّا وهو عصيُّ على التطرّف، وخصوصاً في جانب حفظ النفس الإنسانية التي شدّد الإسلام على مكانتها فقال تعالى: ((مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)) [المائدة-32]، والآية في نهايتها توضّح للقارئ أنّ الرُّسل قد جاؤوا بالبيّنات التي من شأنها أن تحمي الناس، لكنَّ كثيراً من الناس، ورغم وضوح هذه البيّنات أسرفوا في الأرض.
ما التطرُّف؟
رغم الدعوات الكثيرة لوضع تعريفٍ محدَّدٍ للإرهاب أو التطرّف إلَّا أنَّ الدول العظمى، والأمم المتَّحدة لم يفلحوا حتى الآن في وضع تعريفٍ واضح له، ذلك أنّ الاعتراف بأيِّ تعريفٍ سيشمل حتماً السلوك المتطرّف للولايات المتحدة الأمريكية، وللدُّول الغربية، وللكيان الإسرائيلي.
إضافةً إلى أنَّ المطلوب إعلامياً من مصطلح التطرُّف هو أن يبقى ملازماً للدِّين الإسلامي، وأن يبقى وسمُ التطرّف صورةً نمطيّةً عن الإسلام في عقول الناس، وأن تُعمَّى العقول عن إدراك مدى تطرّف الأيديولوجيات الليبرالية المعاصرة ووحشيَّتها.