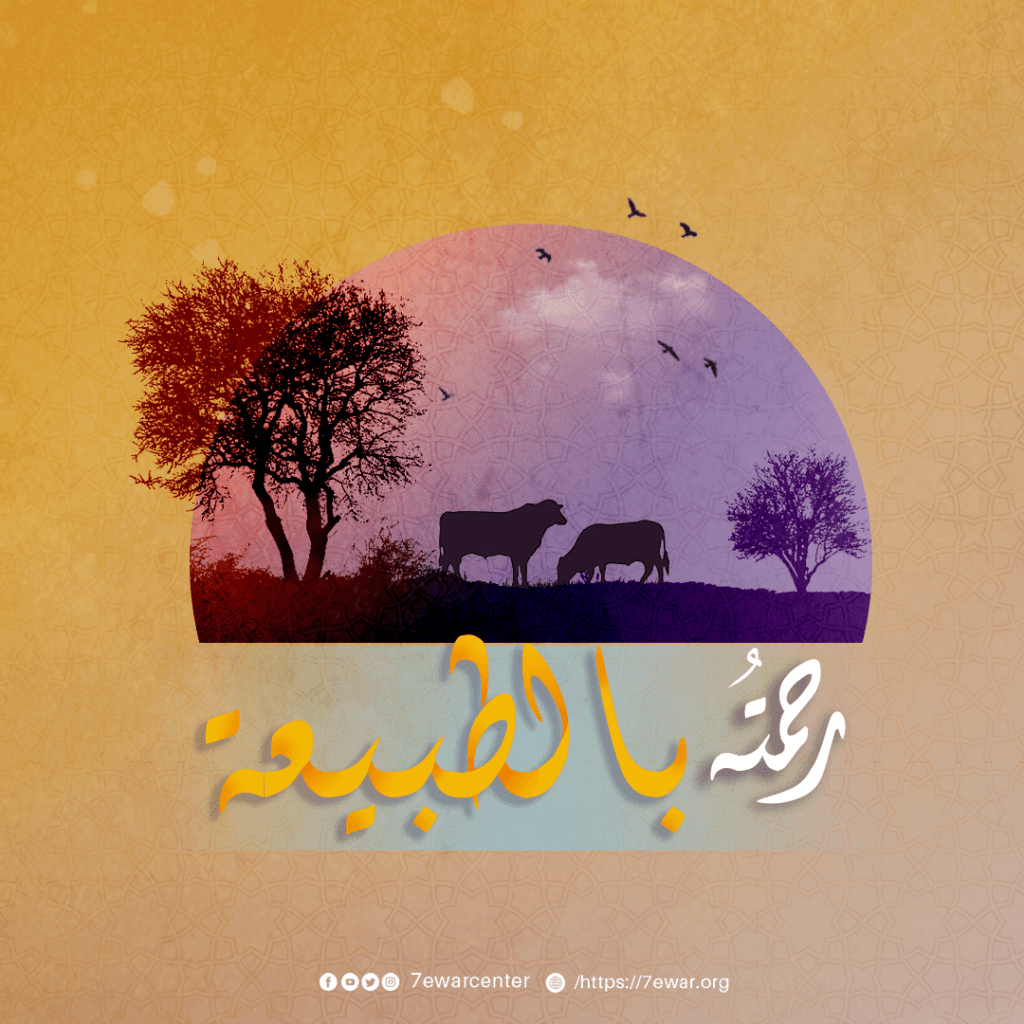الشذوذ الجنسي من الناحية الطبية
بقلم: أ. غالية القصار
![]()
رحمته في الجهاد
الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية: Homosexuality)
الناحية الطبِّية
نظرت المجتمعات الغربية المعاصرة إلى حرية الإنسان نظرةً مختلفةً، ففسحت المجال أمامه لممارسة ما يحلو له دون قيودٍ أو ضوابط، فانساق الإنسان الغربيُّ وراء أهوائه ورعوناته واندفع يلبِّي شهواته خارج حدود التشريعات السماوية التي ما وُجِدت إلَّا لسعادته، فما ناله من وراء ذلك إلَّا الشقاء.
ومع تزايد الجهود التي ترمي إلى نشر الشذوذ الجنسيّ وتطبيعه مع المجتمعات حتَّى أطلقوا عليه:
(المثلية الجنسية Homosexuality) هروباً من مصطلح (الشذوذ الجنسيّ) الذي يعني خروجاً عن التنوع الطبيعيّ، كما يعني في عرف المجتمعات والتشريعات السماويَّة كافَّةً خللاً في المعايير الأخلاقيَّة والدينيَّة واستباحةً للمحرَّمات، بالإضافة إلى سنِّ تشريعاتٍ وقوانين في العديد من دول العالم في أوروبا وأمريكا وغيرها تحمي ذلك الخروج المرفوض عن الفطرة الإنسانية السويَّة، ولذلك كان لزاماً علينا أن نستعرض أبعاد الموضوع وننقل آراء لأطبَّاء وباحثين حول القضية نستبين من خلال ذلك ما عليه حقيقة الأمر.
لمحة تاريخية:
يرى الأطبَّاء النفسيُّون الشذوذ الجنسيَّ (المثلية) مرضاً نفسيَّاً، ونشرت الجمعية الأمريكية للطبِّ النفسيّ (وهي المصدر الرئيسيّ لتشخيص الاضطرابات النَّفسيَّة في أمريكا والعالم) عام 1952م في دليلها للدِّراسات الإحصائية تصنيف المثلية على أنَّها اضطرابٌ وخللٌ نفسيٌ شديدٌ يصنَّف ضمن قسم الانحرافات أو الشذوذ الجنسيّ.1
رفض بعض الناشطين الشواذّ المثليين اعتبار المثليَّة مرضاً، وساهمت ضغوطٌ شديدةٌ مارستها جمعيات المثليين (المدعومة سياسياً) في أمريكا في تشكيل لجنةٍ لمراجعة موقف الدليل. وترى جمعيَّات المثليين ذلك السلوك المنحرف حقَّاً طبيعياً لأصحابه بناءً على ما تقتضيه حريَّة الإنسان التي صانتها الجمعيات الحقوقية العالمية وميثاق حقوق الإنسان في الأمم المتَّحدة، كما اعتبرته ميلاً طبيعيَّاً كأيِّ ميلٍ جنسيٍّ طبيعيٍّ آخر.
فانعقدت لجنةٌ خاليةٌ من أيِّ عالمٍ يعتقد أنَّ المثلية اضطرابٌ نفسيٌّ، وقرَّرت اللجنة بسرعةٍ لم يسبق لها مثيلٌ حذف المثليَّة من الدَّليل التشخيصيَّ وذلك عام 1973م1، ثمَّ أزالت مؤسَّسات الصحَّة النفسية الكبرى حول العالم ذلك التصنيف بمن فيهم منظَّمة الصحَّة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ما يعني أنَّ المثلية في نظرهم توجُّهٌ طبيعيٌ لا مشكلة فيه ولا يحتاج علاجاً، وأنَّه لا يسبِّب أيَّ خللٍ في الحكم أو الاستقرار أو الموثوقيَّة أو القدرات الاجتماعية والمهنية. وهكذا يُستخدم الطبُّ النفسيُّ وسيلةً لإلغاء تجريم الشذوذ الجنسيّ واعتباره خروجاً عن الفطرة السويَّة.
وجديرٌ بالذكر أنَّه في عام 2003م أظهر استطلاعٌ دوليٌّ بين الأطبَّاء النفسيين موقفهم من الشُّذوذ الجنسيّ (المثلية) أنَّ الغالبيَّة العظمى منهم تعتبره سلوكاً منحرفاً على الرغم من استبعاده من الدليل الأمريكيّ للصّحّة النّفسية [الجمعية الروسية للأطبَّاء النفسيين الروس]. كما ذكرت لجنة الصّحّة العامّة في أكاديمية نيويورك الطّبية في تقريرها عن (المثلية الجنسية) 1963م ما مضمونه: (الجنسيَّة المثليَّة مرض، والمثليُّ إنسانٌ مضطربٌ وجدانياً).2
كان لحذف الشذوذ الجنسيّ من التشخيصات المرضية أثرٌ سلبيّ، فلم يعد مسموحاً للأطبَّاء النفسيين معالجة هؤلاء بل على العكس صار واجباً على كلِّ طبيبٍ نفسيٍّ يتعرَّض لاستشارة طبِّيَّة حول الموضوع أن يساعد الشاذّ على تقبُّل ذاته والتكيُّف مع حاجاتها، وأصبحت المراجع الطبِّيَّة الغربية شبه خاليةٍ من تقنياتٍ علاجية لهذا الأمر.
هل يولد النَّاس وهم شاذُّون مثليون؟
هل هناك مورِّثاتٌ تسبِّب الشذوذ الجنسيّ؟
هل هناك سلوكٌ توجِّهه المورِّثات، وتتحكَّم به؟
في سعيٍ حثيثٍ لتبرير الشذوذ الجنسيّ، ونشر فكرة كونه تنوُّعاً طبيعياً مقبولاً، ظهرت ادّعاءاتٌ علميةٌ تربط ذلك الشذوذ بالجينات على اعتبار وجود مورِّثةٍ مسؤولةٍ عن ذلك التوجُّه لا يتحكَّم بها الإنسان كلون بشرته وطول جسمه، وذلك بناءً على بحوثٍ قام بها دين هامر 1993م (وهو عالم وراثة أمريكي)، ادَّعى من خلالها أنَّ هناك صلةً محتملةً بين مؤشِّرٍ جينيٍّ محمولٍ على الكروموسوم x والشذوذ الجنسيّ أو أنّه هو المسبِّب الفعليَّ له3، فدُحضت تلك الادِّعاءات عام 2012م من قبل الجمعية الأمريكية لعلم الوراثة البشرية التي أجرت بحوثاً موسَّعةً ولم تجد دليلاً على ما جاء به دين هامر.4 وفي عام 2015م قدَّمت تلك الجمعية دراسةً نُشرت في صحيفة التلغراف توضح أنَّ المثلية قد تكون ناجمةً عن العوامل البيئية بعد الولادة.5
ولقد واجهت الادّعاءات بشأن وجود ذلك الجين إشكاليةً كبيرةً وهي علاقة الجينات بالسلوك وهذا ما لم يستطع العلم الحديث إثباته حتَّى اليوم.
يقدِّم (دوغلاس آبوت) أستاذ الدراسات العائلية في جامعة نبراسكا في أمريكا شرحاً لهذا فيقول: (يعتقد كثيرٌ من الناس أنَّ الجينات تتسبَّب في سلوكٍ نفسيٍّ مركَّب، لكنَّ الأمر ليس كذلك، ففي أغلب الحالات ينتج السلوك من تأثيرٍ جينيٍّ متفاعلٍ مع العوامل البيئية، وحرية الإرادة الإنسانية، وعندما نقرأ: إنَّ الجين x يتسبَّب في السلوك y فإنَّ هذه مبالغةٌ لا يصدِّقها إلَّا البسطاء من الناس). ويوضح: (الجينات لا تتسبَّب مباشرةً في السلوك).6
وعن دراسةٍ حول المثلية الجنسية يذكر عالم الإحصاء الحيوي والأوبئة (لورنس ماير) 2016م، وعالم النفس (بول ماكهوغ): (لا يوجد دليلٌ علميٌّ موثوقٌ بأنَّ الجينات تحدِّد الميل الجنسيّ لدى الفرد، وإنَّ فهم التوجُّه الجنسيِّ على أساس أنَّه أمرٌ فطريٌّ ثابتٌ بيولوجياً عند البشر غير مدعومةٍ بأدلَّةٍ علميَّة).3
ويتحدث الدكتور الشهير: (نيل وايتهيد) وهو عالمٌ في الأحياء والإحصاء في كتابه: (هل الجينات فعلت ذلك؟) عن ذلك فيقول في خلاصة مؤلَّفه بعد دراساتٍ وبحوثٍ معمَّقة في علم الوراثة والجينات7:
1- لا يرى أحدٌ من علماء الجينات أنَّ الجينات تُملي السلوك وخاصَّة الجنسيَّ منه، لأنَّ الجينات تصنع البروتينات ولكنَّها لا تورِّث الميول.
2- لو كانت الميول المثلية أمراً تُمليه الجينات لكان اختفى نسلها من المجتمع خلال بضعة أجيال، ولما ظهرت اليوم.
3- لم يُكتشف أيُّ سلوكٍ بشريٍّ تحدِّده الجينات. ولا يمكن للسُّلوك الجنسيِّ الشاذّ أن يكون مُسبَّباً عن طفرةٍ في المورِّثات من الناحية البيولوجية.
4- يندرج الميل إلى نفس الجنس (المثلية) بصورةٍ أساسيَّةٍ تحت تصنيف (السِّمات النفسيَّة).
أسباب ظهور التوجُّه الجنسيّ الشاذّ (المثلية)
يؤكِّد علم النفس أنَّ عملية التنشئة هي عمليةٌ يكتسب الفرد فيها نمط سلوكه وتوجُّهه وفقاً لما يمرُّ به من خبراتٍ عديدةٍ ناتجةٍ عن احتكاكه المباشر وغير المباشر مع مختلف الأفراد والجماعات في الأسرة والمدرسة أو حتَّى ممَّا يشاهده عبر التلفاز، وفي وسائل التواصل عبر الإنترنت. ولهذه التنشئة الدور الأكبر في تركيب شخصية الإنسان وميوله من الناحية النفسية والاجتماعية.
وهناك دورٌ أساسيٌّ للتنشئة الاجتماعية في ظهور الشذوذ الجنسيّ، ويظهر أنَّ العوامل الأكثر وضوحاً وتأثيراً تتمثَّل فيما تقدِّمه اليوم بعض المؤسَّسات الإعلامية الضخمة المسيطرة، وما تبثُّه من مضمونٍ مشجِّعٍ ومروِّجٍ لذلك، وإذا أغمض المجتمع عينيه عمَّا يُغرس في عقول أبنائه ولم يقم الآباء والمربُّون بواجبهم في التربية الجنسيَّة الصحيحة باعتبارها جزءاً هامَّاً من عملية التربية، بحث الأولاد عن مصادر أخرى لإشباع فضولهم المعرفيّ في هذا الشأن، وربما اتَّجهوا إلى الأفلام والصور الإباحية، وما فيها من سمومٍ تؤدِّي إلى الاضطراب والانحراف الجنسيّ.
وفي هذا السياق، نشرت عالمة الاجتماع (آميباتلر) بحثاً تحدَّثت فيه عن أنَّ كثيراً من العوامل الإعلامية والاجتماعية والسياسية لها دورٌ كبيرٌ في تحديد الميول الجنسية، وأشارت في بحثها إلى تغيُّرٌ واضحٍ نحو الزيادة في نسب المثلية بسبب ما سبق ذكره.
إنَّ السلوك الجنسيَّ في الأساس هو مفهومٌ ثقافيٌّ يتوقَّف على عوامل ثقافيةٍ واجتماعيةٍ أكثر ممَّا يتوقَّف على عوامل بيولوجية8.
وترجع بعض أسباب الشذوذ الجنسي (المثلية) إلى الانشغال بنمط حياةٍ منحرفٍ، والإدمان على المخدِّرات والمواد الإباحية، أو ربَّما هرباً من صدمةٍ حصلت أثناء فترة الطفولة، كما أنَّ عدداً من المثليين تعرَّضوا لاعتداء جنسيٍّ عندما كانوا يافعين، أو أنّهم يميلون إلى سلوكياتهم الشاذة لملء فراغٍ عاطفيٍّ لم يملأه الأب والأم. ويؤكِّد بعض الباحثين: أنَّ هناك علاقةً سببيَّةً بين المواد الإباحية والتوجُّه الجنسيِّ الشاذ9 .
وترى منظمة (Exodus international: _وهي منظَّمةٌ دينيَّةٌ تعمل على نشر التثقيف الجنسيِّ الصحيح، وتساعد المثليين على التخلُّص من سلوكهم الشاذ_ أنَّ أسباب الشذوذ الجنسيّ تتلخَّص في غياب الأبوين أو أحدهما أو التعرض لاعتداء جنسي، أو قسوة الآباء.9
ختاماً:
بناءً على ما سبق، وبما أنَّ المثليَّة سلوكٌ شاذٌّ لا تسبِّبه تغيُّراتٌ فيزيولوجيَّةٌ جسميَّةٌ حسب الرأي الطِّبِّي، ولا تتحكَّم به عوامل وراثيةٌ، وأنَّه اضطرابٌ نفسيٌّ ناتجٌ عن تأثير العوامل البيئيَّة المحيطة وهذه أشياء قابلةٌ للتَّعديل والمعالجة، فبالإمكان تفادي العوامل المساعدة على ظهور التوجُّهات الشاذّة من خلال زيادة جرعات الوعي الاجتماعيّ والتربويّ، وقبل ذلك زيادة الوعي الدينيّ، فهو صمَّام الأمان في المجتمعات الإنسانية في زمن أضاعت معه البشرية بوصلتها.
المراجع
- Drescher, J. (2015). Out of DSM: Depathologizing homosexuality. Behavioral sciences, 5(4), 565-575.
- السياسات الجنسية والمنطق العلمي_ مجلة التاريخ النفسي رقم5_1992_ د. أوسم وصفي
- Mayer, L. S., & McHugh, P. R. (2016). Sexuality and gender: Findings from the biological, psychological, and social sciences. The New Atlantis, 10-143.
- Harrub, B., Thompson, B., & Miller, D. (2004). ‘This is the Way God Made Me’—A Scientific Examination of Homosexuality and the ‘Gay Gene,’. Reason & Revelation, 24(8), 73-79.
- Ellis, L., & Ames, M. A. (1987). Neurohormonal functioning and sexual orientation: A theory of homosexuality–heterosexuality. Psychological bulletin, 101(2), 233.
- https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2017/8/1/
- Roughton, R. (2003). The international psychoanalytical association and homosexuality. Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy, 7(1-2), 189-196.
8.شاهين_ إيمان فوزي سعيد_ الجنسية المثلية لدى الذكور: تناولٌ وجوديٌّ فينومينولوجي_ مجلَّة كلية التربية جامعة عين شمس_رقم 11_ العدد(3)/2005
- Jahangir, J. B., & Abdul-Latif, H. (2016). Investigating the Islamic perspective on homosexuality. Journal of homosexuality, 63(7), 925-954.