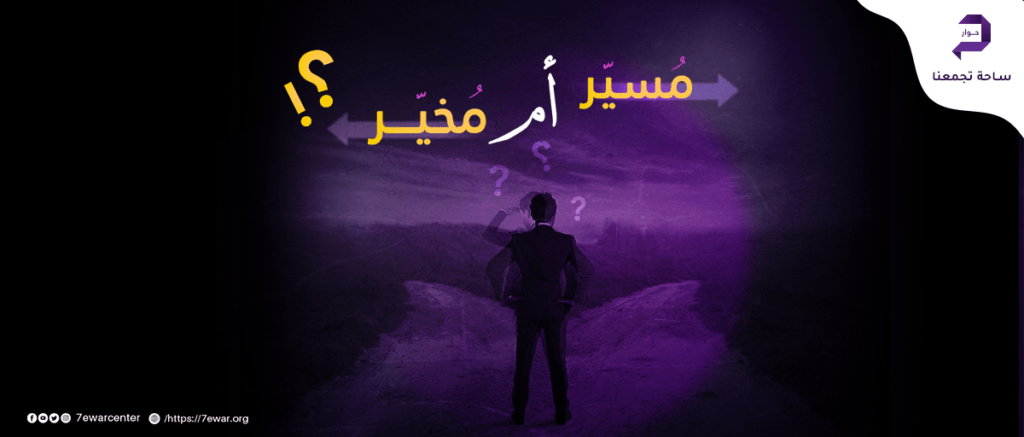القبر وما وراءه
![]()
“إنَّ التخلُّف الذى يعاني منه المسلمون اليوم ليس سببه الإسلام، وإنَّما هو عقوبةٌ مستحقّةٌ من الإسلام على المسلمين لتخلِّيهم عنه لا لتمسُّكهم به كما يظنُّ بعض الجاهلين“
يطرح بعضهم هذا الإشكال: كيف نؤمن بعذاب القبر ولم يذكره القرآن الكريم، ونحن نرى الموتى ولا نرى أثر العذاب عليهم؟! وللإجابة على هذا الإشكال لا بدّ من الاتفاق على المسلّمات التي لا بدّ منها للوصول إلى الجواب:
وأوّلها: هل المعترض يؤمن بالغيب والآخرة أم لا؟ فإن لم يكن يؤمن بالغيب وعوالم الآخرة فإشكاله ليس في عذاب القبر، وإنما في أصل الإيمان، لذا فلا يعنيه هذا المقال.
وثاني المسلّمات: هل المعترض يبحث عن العلم الراسخ الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، واتّبعه الصحابة، واتفق عليه علماء الأمّة على مرّ العصور، وهو الأخذ بالكتاب والسنّة والإجماع، أو يتّبع بعض الأفكار والتيارات السطحيّة المعاصرة التي تنكر السنّة النبوية؟
فإن كان ينكر السنّة النبويّة فإنّ إنكار السنّة أعظم من إنكار عذاب القبر، وإذا كان يبحث عن الحقيقة المجرّدة فعليه أوّلاً أن يعرف ما هي السنّة، وما هو الحديث النبوي قبل أن يسأل عن عذاب القبر، وعليه أن يدرس علم الحديث الذي أبهر عباقرة المستشرقين بمنهجيّته الدقيقة، فاعترفوا بالسبق فيه للمسلمين على الغرب، وإذا تعلّم مصطلح الحديث وأصول الرواية فسيعلم مدى الجهل والسطحية التي عليها منكرو السنّة النبوية.
فإن أبى إلّا إنكار الأحاديث النبوية والاعتراض على إثبات عذاب القبر، فإنّ هذا المقال لا يخصّه أيضاً.
وثالث المسلّمات: هل المعترض يريد أن يفهم القرآن الكريم فهماً حقيقيّاً ضمن منهجيّة علميّة، أو يريد أن يتلاعب بالتفسير والمعاني دون ضوابط، فإن كان يبحث عن الحقيقة فمرحباً به، وليعرض ما يشاء من أسئلة وإشكالات، أمّا إذا كان يعترض لمجرد الاعتراض فننصحه بأن يستغل وقته فيما ينفع الأمة، ولا يغامر بدينه.
ولمن يتفق معنا على هذه المسلّمات نقول: اتفق الصحابة الكرام على وجود عذاب القبر، فلا خلاف فيه عندهم البتّة، وبه قال جماهير المسلمين من التابعين والعلماء من بعدهم، وقالوا بثبوت عذاب القبر؛ لورود الأدلة المستفيضة الصحيحة والصريحة فيه، وما شذّ عنهم إلاّ قلّة قليلة من بعض المعتزلة أنكرت عذاب القبر دون دليل، وإليك بعض الأدلّة على ثبوت عذاب القبر:
أولا: أدلة عذاب القبر من القرآن الكريم:
وردت آيات كثيرة في القرآن تشير إلى عذاب القبر ونعيمه، وسنقف عند بعض منها خشية الإطالة:
1- يقول الله عز وجل عن آل فرعون: (﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: 46]، فقد فسّرها علماء الصحابة والسلف بأنّ هذا العرض لآل فرعون على النار هو عذاب القبر الذي يلاقونه ما دامت السماوات والأرض، وعن عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية: (أرواح آل فرعون في أجواف طير سود، يعرضون على النار كل يوم مرّتين يقال لهم: هذه داركم فذلك في قوله تعالى: {يعرضون عليها غدواً وعشياً}) [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (6/ 1222)]، وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» [متفق عليه].
وممّن ذهب إلى هذا من علماء التابعين: مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب، فقالوا: هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا، ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة في قوله تعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ [تفسير القرطبي: (15/ 319)].
2- قال الله سبحانه عن الظالمين: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الأنعام: 93].
فقد ذكر الإمام البخاري بعض الآيات ومنها هذه الآية والتي قبلها في باب: (عذاب القبر) ليدلّ على ثبوت عذاب القبر في القرآن الكريم، قال ابن حجر: (وكأن المصنف [أي البخاري] قدّم ذكر هذه الآيات لينبّه على ثبوت ذكره في القرآن) أي عذاب القبر وفي قوله تعالى: ﴿ولو ترى إذ الظالمون في غمراتِ الموتِ والملائكةُ باسطو أيديهم﴾ [الأنعام93]، قال ابن حجر أيضاً: هذا عند الموت، والبسط هو الضرب، أي يضربون وجوههم وأدبارهم.
ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال: ﴿فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم﴾ [الأنفال50]، وهذا وإن كان قبل دفن الميت فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة، وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه)[ فتح الباري: (3/ 233)].
3- قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 169 – 171].
فإذا كان الله تعالى يحيي الشهداء الحياة البرزخية ليرزقهم، فيجوز أن يحيي الكفار ليعذبهم في قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ ويكون فيه دليل على عذاب القبر ونعيمه [انظر: تفسير القرطبي (2/ 173)].
4- قوله تعالى:﴿وإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك﴾ [الطور: 47]، أي أنّ الكفار لهم عذاب دون عذاب الآخرة، قال ابن عباس عنه: (عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة) [إثبات عذاب القبر للبيهقي: (ص: 63)]
وهناك آيات أخرى وردت في هذا الصدد، ولكن نكتفي بما ذُكر.
ثانياً: الأدلّة من السنّة النبويّة:
كثرت الأحاديث النبوية التي تثبت عذاب القبر، وإليك بعضاً منها:
1- عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ نزلت في عذاب القبر» [البخاري (1369) مسلم: (2871)].
2- عن عائشة رضي الله عنها: «أن اليهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلّى إلا تعوذ من عذاب القبر» [أخرجه البخاري (1372)].
3- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: قالت: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فذكر فتنة القبر التي يُفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة» [البخاري (1373)].
4- عن البراء بن عازب، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجلٍ من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يُلحَد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه، فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين، أو ثلاثا، وقال: «وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ … «ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قال: فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، وألبسوه من الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها قال: ويفتح له فيها مد بصره.
قال: وإن الكافر فذكر موته، قال: وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه هاه، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فينادي مناد من السماء: أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، قال: فيأتيه من حرّها وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» [أبو داود: (4753) ]
5- عن عائشة، وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» [البخاري: (832) مسلم: (589)].
6- ورد في آخِر حديث صلاة الكسوف الطويل: «ثم رفع [أي رسول الله صلى الله عليه وسلم] فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» [البخاري: (1050) مسلم: (903)].
7- عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأَعِذْه من عذاب القبر -أو من عذاب النار-» قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت [مسلم (963)]
8- عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل، والهرم، وسوء الكبر، وفتنة الدنيا وعذاب القبر» [مسلم: (2723)].
9- عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: «إنهما ليُعَذَّبان وما يعذبان من كبير»، ثم قال: «بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله» قال: ثم أخذ عودًا رطبًا، فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» [البخاري: (1378)].
10- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أَقبُر ستة أو خمسة أو أربعة .. فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأَقْبُر؟» فقال رجل: أنا، قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، لدعوتُ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر..» [مسلم: (2867)].
– فإن قال قائل: لو كان عذاب القبر حقاً لرأينا آثاره على الأموات.
فالجواب:
1- إنّ الله تعالى أخفى عذاب القبر ونعيمه وجعله من عالم الغيب، كالإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر..، لتتحقّق الحكمة، ويتبيّن المؤمن من الكافر، ولو رأينا العذاب بأعيننا لما ظهرت الحكمة من الإيمان به.
2- إنّ عذاب القبر ونعيمه جائز عقلاً وعادةً، بل تقع صورة مصغّرة عنه مع كلّ إنسان في المنام، فكما أنّ النائم قد يشعر بألم أو سعادة في أحلامه، والذين حوله لا يشعرون بما يحصل معه، كذلك الميت يُعَذّب أو يُنَعّم ولا يشعر به الأحياء.
3- صرّح عدد كبير من الناس فقدوا وعيهم ثمّ عادت إليهم الحياة، بأنّهم في حالة فراقهم للحياة رأوا نعيماً أو عذاباً، حتّى ذكر أحدهم، وهو مسؤول عربي، توقّف قلبه لمدّة دقائق وشعر بأنّه في عالم آخر من الوحشة، ثمّ رأى أشخاصاً كان يُحسن إليهم، وبشّروه، ثمّ عادت إليه نبضات قلبه ورجع إلى الحياة، وقد ذكر ما رآه أمام الملأ [انظر إحدى هذه المقاطع] عبر الرابط: (تجربة الموت، صائب عريقات):
https://www.youtube.com/watch?v=vSkDpFDgL-w