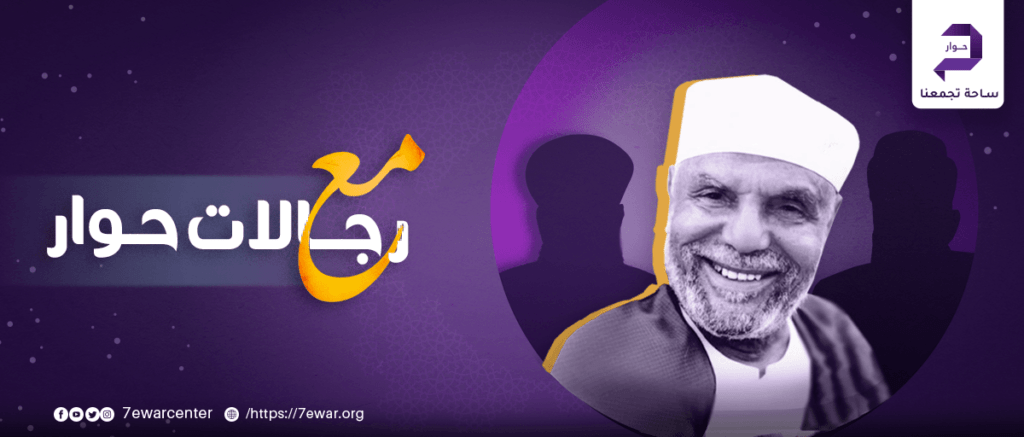الرجل الكبير يحفظ شرفه، ويسفك في صيانته الدم، والمؤمن الحرُّ يحمى عرضه، ويبذل دونه الروح، وقد جاء في الحديث: «إنَّ الله يغار وإنَّ المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرَّمه الله».
إنَّ الله عزَّ وجلَّ يغضب على من يُقارِف محارمَه، وعلى من يستهين بحدوده، فإذا ارتكب أحدٌ معصيةً أو أهمل فريضةً، فلا تحسبنَّ أنَّه أتى أمراً سهلاً لقد اقترف جريمة يستحقُّ بها العقوبة، وخاصم ملكاً شديد البطش أليم الأخذ، والشخص العاصي شذوذٌ في ملكوتٍ يسبِّح بحمد بارئه، ويخضع لأمره، ونكتةٌ سوداء متمرِّدةٌ في عالم يسجد لله طوعاً أو كرهاً، ويستمدُّ منه حياته وبقاءه، لحظةً بعد أخرى.
وذلك العوج في الكون المستقيم على أمر الله هو الذي يجعل الأرجاء توشك أن تنقضَّ على العاصي فتُخفي رسمه ووسمه.
﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ [سبأ_9]
ولولا أنَّ رحمة الله تغلب غضبه، وأنَّه يمهل الخاطئين ليمنحهم فرصة المتاب وينسأ لهم في الأجل، ويمدَّ لهم في الحياة كي يرجعوا إلى الله بخيرٍ يرشِّحهم لعفوه… لولا هذا لسلَّط عليهم عذاب الاستئصال.
﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر_45].
﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [طه_129].
ومع هذا الإرجاء، فإنَّ المجرمين قد يواقعون مآسي تستعجل النقمة، فإمَّا أن يسرع الله بعقابهم عدلاً في الحكم وإصلاحاً للأرض، وإمَّا أن يتدرَّج في إيقاع الجزاء الدنيوي بهم، لعلَّ هذه الأخذات المحدودة توقظ ما نام من ضمائرهم، إلى طريق الرشاد مرَّةً أخرى.
﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ(45)أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ(46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (47)﴾ [النحل_45].
الأصل أنَّ الخطيئة تفعل أوَّلاً في خفاءٍ واستحياء، ثمَّ تفعل في جفاءٍ وبرود، ثمَّ تولد في المجتمع فتبرز بوجهها الكالح، فإذا وجدت بيئةً مواتيةً استوت على قدميها فتفعل الخطيئة دون تكبُّر.
ثمَّ يشتدُّ عودها وتصلب فتشيع وتنتشر، ولا تزال دائرتها تنداح حتَّى تصبح تقليداً متَّبعاً، فإذا ظهرت الفضيلة المناوئة لها
استكثر حقّ الحياة والاستقرار عليها.
مثلما وقع في قرى المؤتفكة! فإنَّ الرِّجال الذين استمرؤوا الشذوذ الجنسيَّ عزَّ عليهم أن يقوم فيهم ناصحٌ ينهاهم عنه! وكان صوت هذا الناصح من الغرابة بحيث هدَّده المجرمون بالرَّجم إن لم يسكت، فلمَّا أبى إلَّا إعلان سخطه والبراءة من عملهم تقرَّر طرده من البلد الفاسق، لأنَّه متطهِّرٌ خارجٌ على القانون!
والبلد الذي تصل فيه الأوضاع إلى هذا الدرك السافل لابدَّ من أن تحلَّ به العقوبة العدل، وما تقوم لأهله عند الله حجَّةٌ، أو ينهض لهم عذر.
إنَّ الإسلام بادي الصرامة في محاربة الرذائل لا يفتر عن مهاجمتها، ولا تنكسر حدَّته في مطاردتها.
على أنَّ الإسلام يفرِّق بين نوعين من المعاصي:
النوع الأول: ذاك الذي ينزلق إليه البشر وهم شبه مغلوبين على إرادتهم وإدراكهم، في أوقات الضعف التي تلمُّ أحياناً بالإنسان فيزلّ، وما يكاد يسقط حتَّى ينهض، وما يكاد يحسُّ لذَّة الهوى حتى تنغِّصه آلام الندم.
هذا النوع من المخالفة لأمر الله يتلطَّف القرآن في مداواته، ويأخذ بيد صاحبه ليعاود نشاطه الأول في أداء حقوق الله وإنفاذ وصاياه.
والتجمُّعات التي تنجم فيها هذه المعاصي -ولا يخلو مجتمعٌ بشريٌّ من غبارها- لا تستهدف لعقابٍ عام ولا تسقط،
إنَّها تشبه أيَّ حقلٍ زرعه صاحبه قُطناً أو قمحاً فتنبت فيه أعشاب وحشائش لم يقصد ظهورها، بل إنَّه يعمل بهمَّةٍ في اقتلاعها وحماية زراعته منها.
وفى سورٍ كثيرةٍ من الكتاب الحكيم نرى المولى تبارك اسمه يتجاوز عن هذه السيئات ويعلن سعة رحمته لمن يلمُّون بشيءٍ منها.
أمَّا النوع الأخير: فهو ذلك الشرُّ المتعمَّد المستقرُّ الذي تتواطأ الجماعة على فعله، وتتعاهد نماءه، وتجعل بقاءه جزءاً من حياتها، وتقيم العرف العام والتشريع الماديَّ والأدبي على أساس منه.
كالمجرم الذي يزرع أرضه بشجر الحشيش والأفيون، ويبقى طول السنة يتعهَّد ما غرس، وهو يعي أتمَّ وعيٍ ما سوف يقدِّم للنَّاس من سموم.
هذا النوع من العصيان لأوامر الله، والإهدار لحدوده، هو الذي نزلت الآيات بأعنف الترهيب منه، ووصفت بإيضاحٍ مصائر الذين رتعوا فيه، وهي مصائر مشؤمةٌ يكتنفها الخراب والدمار، وحذَّرت الأخلاف أن يسيروا نحو الهاوية التي انزلق إليها أسلافهم.
﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأعراف_100].
إنَّ الأمم الفاسدة تلتقي في أحوالها نعوتٌ واحدةٌ، قسوةٌ لا ترِقُّ لضعفٍ، وجحودٌ لا يكترث بوعظ، وعكوفٌ على الدنيا لا يهتمُّ لما بعدها، ونسيانٌ لله لا يبالي بحقِّه.
وبقاء الأمم بهذه المثابة بلاءٌ على العالم، وعلى العمران، وعلى المثل العليا، وضربات القدر القاصمة عندما تنزل بها تكون كحكم الإعدام عندما ينفَّذ في مجرمٍ أثيم.
﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58)وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص_58].
والخوف من الإبقاء على هذه الأمم، سرُّه الحرص على إنشاء أجيالٍ أسلمَ فطرةً وأقوم قيلاً.
ولذلك ترى القرآن الكريم يُكثر من عرض حياتها وعملها وعقباها، حتَّى يمكن إيجاد أخلافٍ أتقى أفئدةً، وأزكى مسلكاً، ويقلِّبها بين صنوف السَّرَّاء والضَّراء حتَّى تعقل وترعوي… أو ينبت خلالها من يعقل ويرعوي.
وكم أخشى على الناشئة التي تنمو الآن في الشرق الإسلامي؟
إنَّها تشبه خضراء ((الدِّمَن)) في حسن منظرها، وسوء مخبرها، وخضراء الدِّمَن تربو على الأقذار كما تربو البهائم الجلالة على التقاط القمامة، فترى شكلها جميلاً، وطعمها مريراً!
واليوم نبصر أقواماً شاهت طباعهم يظنُّون سعة الثقافة في سرعة الإلحاد، وحرِّيَّة الفكر في هوان الإرادة واستمراء الشهوات، والتقدُّم المستحبُّ هو البعد عن فرائض الله؛ من صلاةٍ وصيامٍ، بل الاندهاش لرؤية المصلِّين والصُّوَّام!
وتسمع أولئك العلوج وهم يتكلَّمون عن وجوب فتح حانات الخمور، وتهيئة صالات العهر، لأنَّ موارد السياحة ستنضب إن لم يقدَّم للسائحين المسكر الذي يشربون، والمرأة التي يشتهون! فتجزم بأنَّك أمام أمساخ خلقٍ وأنصاف أو أعشار بشر!
وقد أسلفنا القول إنَّ بلوغ المعصية هذه المنزلة إيذانٌ بنقمة الله.
وإنَّنا لنتشاءم من مستقبل أجيالٍ تحيا وسط هذا الركام الكثيف من سوء الفهم والتوجيه، وما نراها أبداً تصلح لحمل الأعباء أو مخاصمة الأعداء!
ويجمل بي أن أثبت هنا إجابةً على سؤالٍ بعث به المعنيُّون بالنشاط الاجتماعي في ((كلية التجارة، جامعة عين شمس)).
وهو: «يجتاز الشباب فترة قلقٍ نفسيٍّ لا يستطيع معها تحديد أهدافه، ولا رسم مُثُله العليا، فما الأسباب التي ترونها داعيةً إلى ذلك؟ وما العلاج الذي تقترحونه؟».
وقد ألَنَّا القول في هذا الجواب، وأضعفنا حدَّته، ولجأنا إلى التلميح بدل التصريح، والخفوت بدل المجاهرة، لعلَّ هذا التلطُّف يُجدي!
وهاك البيان:
إنَّ فترة القلق التي يعانيها الشباب نتيجةٌ طبيعيةٌ لجملة أسبابٍ تجمَّعت في حياتهم كان لابدَّ أن تترك آثارها في أنفسهم على ذلك النحو الذي جزع له المصلحون، وشرع في تفهُّمه ومداواته لفيفٌ منهم.
ومن واجب المسؤولين عن قيادة الشباب أن يلتمسوا الدَّواء لهذه العلل، فإنَّ الشباب الذي لا هدف له، إمَّا أن يقف في مكانه مبلبل الخواطر مشتَّت المشاعر، وإمَّا أن يخبط في الحياة على غير هدى، وبذلك يبدِّد قواه عبثاً ويضيعها سُدى!
وكلا الأمرين خطرٌ على مستقبل الفرد والجماعة.
وهنا يجيء السؤال: ما سرُّ هذا الفراغ النفسيّ، وما يتبع ذلك الفراغ من خلخلةٍ وحيرة؟
والجواب يفرض علينا أن نتأمَّل طويلاً في الأغذية المعنويَّة والروحية التي تُهيَّأ للشباب، وتعمل عملها في قلبه ولبِّه!
ومن اليسير أن نحصر هذه الأغذية في مصدرين اثنين:
أوَّلهما: ما يقدَّم خارج الفصول والمدرَّجات، أعني بعيداً عن معاهد الدراسة وتوجيهات الأساتذة.
والآخر: ما يقدَّم خلال مراحل التعليم المختلفة من بداية الصفوف الدنيا، إلى أن يترك الطلَّاب جامعاتهم ويواجهوا الحياة العملية. ونستطيع القول في إجمالٍ وتعميم: إنَّ كلا المصدرين فقيرٌ في المواد التي تكوِّن العقائد الدافعة، والتي ترسم الغايات البرَّاقة، والتي تحشد المشاعر وتحكم العزائم، وتشحذ الهمم، وتُغري باقتحام المجهول، والجرأة على الغيوب دون وجلٍ ولا تهيُّب.
والإنسان من غير عقيدةٍ تعمر فؤاده… هذا الإنسان كمٌّ مهملٌ، وحركةٌ موضعيةٌ، إن لم تكن حركةً انسحابيةً إلى الوراء.
والشبـاب الذي لا عقيدة له، أو الذي يحمل عقيدةً منفصلةً عن شعوره وعن تفكيره، لا يمكن إلَّا أن يحيا قلقاً، وإلَّا أن تمتلكه الحيرة، ويستولى عليه التردُّد، وهو يرمق مستقبله بخَوَرٍ وارتباك!
ولنلق على الموضوع كلِّه نظرةً أعمق.
ما الأهداف التي تغرسها في الشباب حياتنا العامة؟
أستعرض على عجلٍ، ما تنشره الصحف اليومية والأسبوعية، وما يذيعه الراديو على موجاته الطِوَالِ والقِصَار، وما تعرضه السينمات والمسارح، إنَّ هذا الاستعراض السريع يجعلك تحكم على البديهة بأنَّ الأغذية المعنوية التي تقدِّمها هذه الجهات الثلاث، بعضها تافهٌ غثٌّ، لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبعضها سمومٌ تفتك بالعافية الروحية، وتنشر في أفاق الشبان ظلالاً سوداً للتحلُّل والميوعة.
إنَّ الدول في كثيرٍ من الأحيان توجِّه اقتصادها لخدمة مصالحها القومية العليا وترسم لذلك سياسةً دقيقةً تلزم الجميع بتنفيذها والرضا بأثارها.
فهل هناك أدبٌ صحافيٌّ موجَّهٌ، أو فنٌّ مسرحيٌّ موجَّهٌ، أو برامج إذاعيَّةٌ موجَّهةٌ تتضافر كلُّها على تكوين جيلٍ ناضجٍ مُكتمل الوعي، نيِّر الفكر، صلب الإيمان، واضح الهدف، قويِّ العقيدة؟
إنَّني أمدُّ بصري اليوم في غير تكلُّفٍ إلى صحيفة الأهرام فأجد هذا العنوان مكتوباً على مساحة أربعة أعمدة بخطٍّ كبير: ((ليندا… مازالت تحبُّ نايرون باور))!
يا الله! أَبَلَغ هوان قرائنا إلى حدٍّ العناية بهذا السخف!
وإذا فرضنا أنَّ بعض السفهاء يهتمُّ بذلك النبأ، فهل رسالة الصحافة أن تقوِّم ذلك العِوَج النفسيَّ أم تنمِّيه!
وقل مثل ذلك في الصور العارية والأخبار المثيرة…
إنَّ صحافتنا تنشئ الدنايا إنشاءً؛ لتفسد بها الضمائر الساذجة.
وهل تتبَّعت ما يطلبه المستمعون في إذاعتنا؟
الغريب أنَّ أحداً من أولئك الطالبين لم يرغب في سماع أغنيةٍ قوميَّةٍ كقصيدة فلسطين مثلاً، أو أغنيةٍ جادَّةٍ ذات موضوع نبيلٍ وغايةٍ سامية!
الزحام كلُّه على الألحان الطرية، والأنغام العليلة، والأصوات الخبيثة التي لا تملُّ الشكوى من الهجر والخصام!
فهل وظيفة الإذاعة بثُّ الهيام وإقلاق المنام وراء الحبيب المدلَّل!
أليس هناك توجيهٌ أعلى يرفع المستوى النازل، ويحيي في النفوس ملكاتها الطيبة؟
ثمَّ ألمحُ الروايات التي تمثل أحلام الكبت، أو التي تحسم وساوس الغريزة، والروايات التي تجعل طريق الفضيلة عسِر السلوك مبهم النتائج، أو التي تهوِّن الخيانات وتحلِّي مذاق الرذائل!
إنَّ عرض هذه الروايات في السينما أو المسرح لا يمكن أن يأتي بخيرٍ أبداً، بل إنَّ الشرور المتولِّدة عنه فوق الحصر.
والشباب الذي تُحاصره هذه العلل كلُّها قلَّما تواتيه فرصُ الإفلات من غوائلها.
ومن ثمَّ فهو يعجز حتماً عن تحديد أهدافه ورسم مثله العليا، وهناك خللٌ أخر في حياتنا العامة: ندرة المؤسَّسات الاجتماعية التي تنمِّي في الشباب نزعات العمل الكريم، وتنفِّس عن رغبته الكامنة في الامتداد والحركة، وتتلطَّف في توجيهه إلى الواجب المرتقب منه.
نعم، هناك أنديةٌ رياضيَّةٌ تقوِّي الأبدان، وتيسِّر أنواع اللعب، وتخلق العضلات المكتنزة.
لكن ما جدوى صناعة الأجسام المفتولة إذا لـم تملأ هذه الأجسام نفوسٌ مُشرقةٌ بالأمل الصحيح، توَّاقةٌ إلى الكدح في سبيل الله والناس!
إنَّ إيجاد هذه المؤسَّسات أمرٌ لا محيص عنه إذا أردنا الخير لأمَّتنا عامَّةً ولشبابنا خاصَّةً.
والآن، لنترك ما وراء جدران المدرسة، ولندخل المدرسة نفسها…
إنَّ البرامج التي تدرَّس كثيرةٌ ومنوَّعة، والجهود التي تنفق في شرحها وتثبيتها مشكورة، بيد أنَّ العلم وحده مهما زاد، والثقافة مهما اتَّسعت، لا تكوِّن شخصيَّةً متكاملةً ناضجة.
وقد تتراكم المعلومات في ذهن الطَّالب كما تتراكم السلع في مخزن تاجرٍ لا يُحسن العرض، أو لا يريد البيع!
أو كما تستعدُّ السيارة للانطلاق لسلامة آلاتها ووفرة بترولها، ولكنَّها تفقد السائق الذي يتولَّى قيادها ويتَّجه بها حيث يشاء!
ما قيمة العلم الميت في نفوسٍ جاهليَّة! ما قيمة الدروس المستوعبة إذا كانت هذه الدروس معزولةً عن الحياة الخاصَّة والعامَّة يدَّخرها صاحبها في ذاكرته فحسب، ثمَّ هو يهدأ أو يتحرَّك ويفتر ويتحمَّس بعوامل أخرى؟
إنَّ العلم لابدَّ أن تصحبه تربيةٌ دقيقةٌ، لابدَّ أن تصحبه أخلاقٌ موجَّهةٌ، لابدَّ أن تصحبه معنويَّاتٌ رقيقة.
والتربية المنشودة ليست دروساً تُلقى، إنَّما هي جوٌّ يُصنع، وإيحاءٌ يغزو الأرواح باليقين الحيّ والعزيمة الصادقة.
ونعود إلى ما بدأنا الحديث به، نعود إلى توكيد الحاجة الماسَّة إلى العقيدة، فإنَّ الإيمان يصنع العجائب، ويخلق وسائل النجاح من بين طيَّات العدم واليأس…
وإذا اعترفنا بأنَّ النهضات لا تنجح ولا تُثمر إلَّا إذا قامت على إيمانٍ راسخ، ويقينٍ جازم، فبقي أن نبحث من أين نجيء بالعقيدة التي نفتقر إليها.
أَنَتَسوَّلُها من خارج بلادنا؟ أَنَسْتَوردُها من هناك بثمنٍ غالٍ أو زهيد؟
أم نعود إلى تاريخنا ومقوِّمات حضارتنا لنتعرَّف الركائز التي نبني فوقها ونُعلي البناء؟ إنَّني شخصياً لا أتردَّد في الاختيار، وإنَّني أوقن بأنَّ القلق النفسيَّ، والاضطراب الذِّهنيَّ، وغموض الأهداف، وخفاء المثل الرفيعة… كلُّ هذا سوف يزول إذا وصَلنا الشاب بتاريخه العتيد، وملأنا قلبه بالروحانية السَّمحة، واليقين النقيّ، والخلق الجاد.

![]()