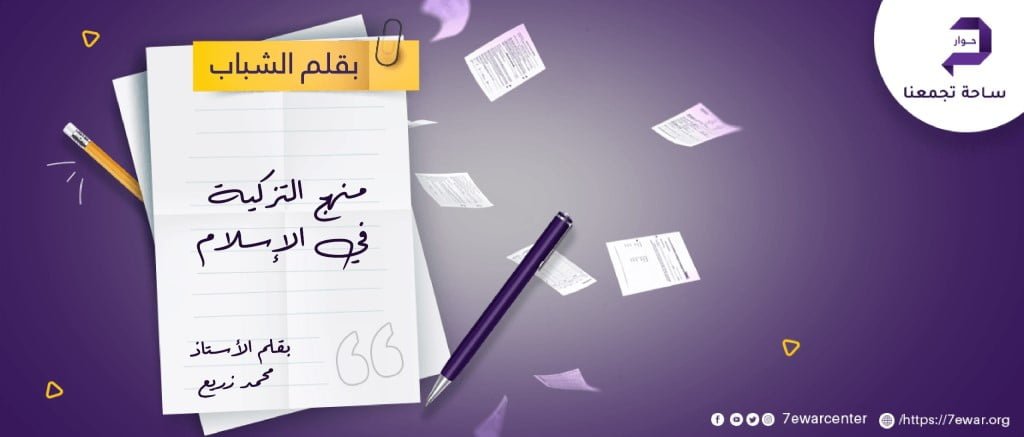ينشر بعض من يدّعي دراسة الحديث النبوي أبحاثاً ودراساتٍ في انتقاد السُّنَّة النَّبويَّة وصحيح البخاري، ويشكّك في الثوابت، ويخرج بالمغالطات العلمية، التي تنمّ عن عدم درايته في الصَّنعة الحديثية، ثمّ يسخّف منهجيّة علماء الحديث وتفكيرهم، ويتّهمهم بأنّهم بعيدون عن العقلانيّة والتفكير المنفتح السليم، وأنّهم يضعون هالةً من القداسة على النصوص مبناها على العاطفة لا على العلم.
والمشكلة لا تقتصر على هؤلاء “الباحثين” لكنّها تتعدَّى إلى جمهور المسلمين ممَّن ليسوا من أهل الاختصاص، فيصدّق بعضهم هذه المغالطات، ويتبنَّون تلك الأفكار المبنيَّة على الوهم، ويقدحون بعلماء الحديث، وينسفون السنّة النبويّة بأكملها، ويظنُّون أنّ هؤلاء الباحثين يتحرّون الحقيقة العلميّة في انتقادهم للسُّنّة، وطعنهم بالمحدِّثين، وزعزعة الثوابت والأصول.
على أنّ ثوابت الدِّين وأصوله ليست فِكراً كي تقبل النقد، ولا ثقافةً كي تتغيّر أو تتلوّن بتلّون الشعوب، بل هي قائمةٌ على أدلّةٍ قطعيّةٍ كقطعيّة الشمس في رابعة النهار، ولو اطّلع المشكّك على منهجيّة العلماء الدقيقة الراسخة في تقريرها لخجل من جهله.
فمن أراد أن يُظهر ذكاءه وعلمه فليبدع في اختصاصه -فالمشكّكون لا علاقة لهم بالعلوم الشرعية- وإذا أرادوا النفع فليقدّموا للإنسانية شيئاً مفيداً ضمن اختصاصاتهم العلميّة والأدبيّة، وليساهموا في حلّ مشاكل البشريّة التي تزداد تعقيداً، ويَدَعوا أهل الاختصاص الشرعيّ يبحثون ضمن اختصاصهم، لا أن يأتوا بالمغالطات والطعون والتشكيكات المبنيَّة على الأوهام والتناقضات العلمية، ويصوغوها بمظهر العقلانيّة وهي لا تعدو أخطاء وتناقضاتٍ علمية، ثمَّ يقومون بتسفيه أهل الاختصاص من العلماء الراسخين الذين قضوا حياتهم في دراسة كتاب الله وسنّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم بدقائقها وتفاصيلها منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا.
أفيُعقل أن تكون الأمَّة بأسرها على جهلٍ وضلالٍ منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا! حتَّى ظهر اليوم أشخاصٌ أجانب عن العلوم الشرعيّة، لا يحسنون قراءة الآية القرآنية ولا الحديث النبوي ليدّعوا أنَّهم قد اكتشفوا الحقيقة التي جهلها المسلمون!
أَوَ يُعقل في عصر العلم والاختصاصات الدقيقة أن يُفسح المجال لكلّ صادرٍ وواردٍ ليطعن في السُّنَّة النَّبويّة عن جهلٍ ومغالطاتٍ، ويُقَلَّد وسام الإبداع!
وفيما يلي أنموذجان من آلاف النماذج المبنيّة على الأخطاء العلميَّة وقد انتشرا وأُعجب بهما جمهورٌ عريض، دون أن يدركوا ما يحتويانه من مغالطاتٍ وأخطاءٍ جسيمة.
النموذج الأول:
ذكر أحدهم إشكالاً يسفّه به الإمام البخاري، ويضلِّل به المشاهدين، فيقول:
جاء في صحيح البخاري رقم (323) حدَّثنا هشام، عن يحيى (يعني ابن كثير)، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمِّ سلمة، قالت: (بينا أنا مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مضطجعة في خميلة …) الحديث.
ثمَّ قال: انظروا إلى غباء البخاري، كيف يروي أبو سلمة حديثاً عن ابنته زينب، عن أمّ سلمة بعد زواجها من النَّبيِّ، ولم يتزوّج النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أم سلمة إلَّا بعد وفاته! انظروا إلى هذا التناقض! إنّه في غاية الغباء والكذب.
وإذا عدنا إلى الحقيقة نجد أنّ هذا الناقد يفضح جهله؛ لأنّ أبا سلمة الذي روت عنه زينب بنت أبي سلمة ليس هو أبوها، ولا يظنُّ بعلماء الحديث هذا التناقض إلّا جاهلٌ لا صلة له بهذا العلم ولا بالصنعة الحديثية الدقيقة التي اتَّبعها الإمام البخاري وعلماء الحديث.
فهناك علمٌ عند المحدِّثين يسمَّى: (علم الرجال) يدرسون فيه رواة الحديث النَّبويّ، ويتتبَّعون أحوالهم، وعدالتهم وضبطهم وتثبّتهم في الرواية، وصدقهم وخطأهم ووهمهم، وكلّ ما يتعلّق بذلك، ثمّ يحصرون كلَّ شيوخهم الذين أخذوا الحديث عنهم، وجميع تلامذتهم الذين رووا عنهم الحديث، ليضمنوا صدق الرواية وصحّتها، حتَّى لو ذكر أحدهم حديثاً وقال: حدّثني (فلان)، ولم يثبت أنّ هذا الراوي من تلامذة (فلان) لا يُقبَل حديثه ويتبيَّن كذبه.
ونعود إلى أبي سلمة الذي روى الحديث عن زينب بنت أم سلمة، فهو ليس الصحابي أبو سلمة زوج أمّ سلمة، وإنّما هو التابعيّ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ولكن، بسبب جهل المعترض يظنُّ أنَّه لا يوجد رجلٌ اسمه أبو سلمة إلَّا زوج أمِّ سلمة.
وعندما يُذكر السند: (روى يحيى-يعني ابن أبي كثير- عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمِّ سلمة) فالمحدّثون يعلمون مباشرةً أنّ أبا سلمة هذا هو التابعيّ ابن عبد الرحمن بن عوف، من خلال دراسة علم الرجال، لمعرفتهم عمّن روى عن أبي سلمة، وهو يحيى بن أبي كثير.
قال النووي: (أبو سلمة التابعيّ: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، سمع أبو سلمة جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن سلام، وابن عمر، وابن عبَّاس، وابن عمرو بن العاص،.. وعائشة وأم سلمة.
روى عنه خلائق من التابعين وغيرهم، فمن التابعين عامر الشَّعبيّ، وعبد الرحمن الأعرج، ويحيى بن أبي كثير، وآخرون) [تهذيب الأسماء واللغات: (2/241)].
فعلم الحديث له أهله وأصوله، ومن يدّعي التناقض فيه إنَّما يفضح جهله.
النموذج الثاني:
وهو نموذجٌ عجيب، إذ ينكر صاحبه شخصيّة أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، ويدّعي أنّه شخصيّةٌ وهميّة، وأنّ أبا بكر الصِّدِّيق حسب كتب التراث ما هو إلَّا جنديٌّ غير ذي بال، قُتِل مع عبد الله بن الزبير سنة (73هـ) ولم يكن خليفةً للمسلمين يوماً من الأيَّام، ويأتي بعباراتٍ من الكتب ليؤكِّد كلامه، وفي الحقيقة إنّه يؤكد تخبّطه واضطرابه في إنكار شخصيَّة أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه الذي وردت خلافته بالاستفاضة والتواتر، ولا يختلف فيه أحدٌ من المؤرِّخين (من مسلمين وغير مسلمين).
وإنّه يتعذَّر في المنهج العلميّ الذي يدّعيه هذا المدَّعي إنكار مثل هذه الشخصيّة الثابتة بيقين التي وردت أخبارها بالتواتر، فيقرّر أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق اسمه: (عبد الرحمن بن عثمان شارب الذهب)، ثم يستخدم الخلط التاريخيّ بين ثلاث شخصياتٍ، شخصيَّتان اسمهما (عثمان) وشخصيّة اسمها عبد الرحمن، ليجمع بينها ويخرج باسم: (عبد الرحمن بن عثمان شارب الذهب).
ومَوطن الخلط عنده يبدأ من عثمان بن عمرو (شارب الذهب)، فنقل عن البلاذري وغيره: أنَّ عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد يسمَّى شارب الذهب، وكان له من الأبناء معمر وعمرو وعمير وزهرة وعبد الرحمن، فزعم الناقد أنَّ عبد الرحمن بن عثمان هذا هو أبو بكر الصِّدِّيق، وأنَّه قٌتِل مع ابن الزبير…
لكنَّه لم ينتبه إلى أنَّ عثمان هذا غير عثمان والد أبي بكر، بل هو عمّ أبيه.
وإليك الخلط التاريخيّ الذي وقع فيه:
– الشخصية التي أشار إليها (عبد الرحمن بن عثمان) وادّعى أنَّه هو أبو بكرٍ الصِّدِّيق، ليس هو ابن عثمان بن عمرو (شارب الذهب)، ولا هو ابن عثمان بن عامر (أبو قحافة والد أبي بكر)، بل هو ابن حفيد عثمان الذي هو ابن عمِّ والد أبي بكر الصِّدِّيق، وهو: (عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي، أسلم يوم الحديبية، وقيل يوم الفتح، وكان يقال له شارب الذهب) [انظر: تهذيب التهذيب: (6/227)]، وهو من الرُّواة المعروفين لدى الدارسين للصَّنعة الحديثية، ومن ثمّ يظهر لديه هذا التلفيق والخلط.
– أنَّ عثمان بن عمرو شارب الذهب هو جدّ الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله أحد المبشَّرين بالجنة، واسمه: (طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد التيميّ)، كما هو معروفٌ في كتب التراجم، ويلزم من هذا الخلط أن يكون أبو بكر الصِّدِّيق عمُّ طلحة بن عبيد الله! [أنساب الأشراف للبلاذري (10/ 115)]
– ورد في النقل الذي ذكره ذلك المدّعي عن البلاذري أنَّ لعثمان شارب الذهب من الأبناء: معمر وعمرو وعمير وزهرة، وأنّهم إخوة أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، ومن المعلوم أنَّ أبا بكرٍ ليس له إخوةٌ ذكور، وإنّما له أختان فقط هما أم فروة وقريبة…
– وقد دلّس ذلك المدّعي على الناس في نقله عن البلاذريّ، ذلك أنَّ البلاذريّ حينما تعرَّض لأنساب بني تيم بدأ بأبي بكرٍ الصِّدِّيق وترجم له ترجمةً مستفيضة، ونسبه بنسبه المعروف (عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد التيمي). [انظر: أنساب الأشراف للبلاذري (10/ 51)]
ثمَّ ذكر أبناء عثمان بن عمرو (شارب الذهب) أخو عامر بن عمرو جدّ أبي بكر، وفصل بينهما في النسب [انظر: أنساب الأشراف للبلاذري (10/ 142)]
ثمَّ يسمِّي هذا التلفيق والتخليط بحثاً علمياً، ويعتبره مادَّةً إعلاميَّةً قابلةً للتسويق وإثارة الجدل.[وانظر موقع هوية بريس، مقال بعنوان: حينما يُسمّى التلفيق والتدليس بحثاً علمياً، رشيد أيلال نموذجاً، بقلم د. إبراهيم أيت باخة].
فهذان أنموذجان من آلاف النماذج، وعليهما فقِس تلك الأساليب التي يستخدمونها في الطعن والتشكيك، وهي لا تعدو تخبّطاً وتلفيقاً ومغالطات، وغايتهم من ذلك أن يشكِّكوا بالعلم الذي دوّنه العلماء المسلمون، بقصد زعزعة الثوابت، وإنّ مجرّد لجوئهم إلى هذا الخلط والتلفيق دليلٌ على قوّة علوم المسلمين وسلامتها ورسوخها.