هو… دكتوراه في الكيمياء من جامعة أسيوط… يحمل معه جَلافة الرِّيف وبساطته وطيبته, وهي خرِّيجة آداب قسم سياحة, تحمل معها حقيبة كريستيان ديور, وتنظر دائماً غرباً إلى باريس لتأخذ عاداتها وقيمها وموضاتها… في حين هو ينظر شرقاً إلى مكَّة, معلَّق القلب والفؤاد بالكتب القديمة الصفراء والمدائح النبوية وحلقات الذّكر في سيدي أبو العباس.
وهو في زيارة للسّويد والنّرويج مدعوَّاً في مؤتمر علمي.. وهو يصحب زوجته في شهر عسل…
وهما يهبطان معاً درجات الفندق الفخم في استكهولم… وكلَّما مرَّ بهم نزيلٌ أومأ برأسه في تحية… فتضغط على ذراعه هامسة.
– رُدَّ على التَّحية بإيماءةٍ برأسك أنت الآخر… أترى كم هم مؤدَّبون… تعلَّم… إذا حُيّيتم بتحيةٍ فردُّوا بأحسن منها
أترى النّظافة حولك، كلُّ شيءٍ حولك يلمع… والأرض كأنَّها مرآة… المواعيد بالدَّقيقة والثَّانية… الكلمة واحدةٌ كأنَّها میثاق… لا غشَّ, ولا احتيال, ولا مكر, ولا تعقيد… المرأة هنا حرَّةٌ رشيدةٌ مستقلَّةُ الإرادة، تملك مفتاح عربتها, ومفتاح شقَّتها, وتخوض الحياة بلا خوفٍ, وتختار زوجها في حريَّة… وتعمل في أيِّ مهنةٍ تحبّ… حارسها ضميرها وحده.. يدها مع يد زوجها على دفَّة القيادة… لا رياسة لأحدٍ على الآخر, ولا تحكُّم ولا استبداد… لها نصف ما يملك إذا افترقا… هكذا يضمنون للمرأة مستقبلها هنا, ويؤمِّنونها من غوائل الدَّهر وطغيان الرَّجل… دستور الزَّوجيّة احترامٌ متبادلٌ, ومساواةٌ في الحقوق, وثقةٌ وحريَّةٌ من كلِّ طرفٍ في الآخر, ولا تدخَّل ولا فضول… ولا مساءلة… ولا محاكمة… أين كنت بالأمس؟ ولماذا جئت متأخِّرة؟ تذكرة طائرتها في جيبها, وجواز سفرها في حقيبتها… تُسافر إلى آخر الدنيا وحدها حرَّةً, رشيدةً, مستقلَّة… حارسها ضميرُها وهذا يكفي.
انظر حولك وتعلَّم… هذه هي القيم التي تحتاجها في مصر لنصنع مصر جديدة, وحضارةً جديدةً, ومدنيَّةً جديدة. هذه فرصتك لتغتسل من أتربة الرّيف وتجدِّد شباب عقلك, وتتشرَّب هذه القيم العصريَّة… لا أحب أن أصادر تفكيرك, ولكنّي أطالبك فقط بإعادة النظر, وعدم الرَّفض الفوريّ لأيِّ جديد. لا أحبُّك أن تُشيحَ بيدك وتقول كلمتك التقليديّة: هذه دولة الكفر. فأين ترى الكفر فيها؟ هل النظافة كفر؟ هل الأمانة کفر؟ هل الوفاء بالوعد كفر؟ هل النِّظام كفر؟ هل العلم المتقدِّم كفر؟ هل الصناعة كفر؟
ومرَّت امرأةٌ بيدها كلبٌ, وأومأت برأسها في تحيّة, فرد صاحبنا بإيماءة أخرى من رأسه, فضغطت صاحبتنا على يده في حبٍّ, وقالت وهي تلفت نظره إلى الكلب:
– أترى أصابع الكوافير كيف صفَّفت شعر هذا الكلب, والفيونكة الحمراء الجميلة, هل العطف على الحيوان الضعيف کفر, هل رأيت المستشفى الأنيق أمام الفندق, إنَّه مستشفى للكلاب, ودار حضانة للكلاب, تترك المرأة كلبها في الصباح ثم تعود لتأخذه في المساء.
قال الرَّجل الريفيُّ وهو يهزُّ رأسه غير مصدِّق:
– شيءٌ عجيب.
– هل تعلم أنَّ هناك أكثر من عشرين صنفاً من اللحوم المعلَّبة للكلاب, وأنَّ المحلّ يترك لك الحريَّة لتعرضها على كلبك ليجربها ويختار منها ما يحبّ.
قال الرّجل الريفيُّ وهو مازال يهزُّ رأسه:
– شيءٌ عجيب, إذا كانوا يصنعون هذا بالكلاب, فماذا يصنعون لبني آدم؟
– سوف ترى يا عزيزي, لا تتعجل.
– إذا كان هذا مقام الكلب في الأسرة, فماذا يكون مقام الأسرة في المجتمع؟
– سوف ترى بنفسك الليلة, ألسنا مدعوَّين معاً إلى تلك العائلة السويديّة؟
– نعم, نعم, لقد دعانا الدّكتور كرافت على فنجان شاي لنحدِّثه عن مصر, وعن أخبار مصر, فهو عالمٌ في المصريَّات كما تعرفين.
– بل نريده أن يحدِّثنا هو عن بلاده, وعن المعجزة الأوربية.
– نعم, صدقتِ.
***
وفي المساء كان الدكتور كرافت يمدُّ يده ليصافحهما بحرارةٍ وهو يقول:
– أخيراً جاءت مصر إلينا, أخيراً أصافح أحفاد حتشبسوت وأخناتون يداً بيد.
قال الرَّجل الريفيّ:
– لا أظن فقد اختلطت الأنساب كثيراً في بلادنا يا عزيزي الدكتور بقدر ما تَعاقَب عليها من فرسٍ, ورومٍ, ومقدونيّين, وهكسوس, وعرب, وإنجليز, وفرنسيين, لا أظنُّك اليوم تجد حفيداً واحداً حقيقياً لحتشبسوت أو أختاتون, لن تجد هذا الحفيد إلا في مقابر تل العمارنة في تابوتٍ سُرِقَ كلُّ ما فيه, ولم تبق إلَّا الجثة.
قال الرجل وهو يتنهَّد آسفاً.
– صحيح, هذا مؤسف, لم يبق لنا إلَّا تاريخٌ, ومعابدُ, وبرديَّاتٍ هيروغليفية.
ورشف الدكتور كرافت رشفةً هادئةً من فنجان الشاي.
– لو كنتما هنا أمس الأحد, لسعد أبواي بكما كثيراً, فهما مثلي يحبَّان مصر كثيراً, ويتنسَّمان أخبارها.
قال الرجل الرّيفيّ:
– وأين هما يا ترى؟
– هما عجوزان لطيفان, وهما في هذه السّن التي يصعب فيها التفاهم والتواصل بينهما وبين باقي الأسرة, وحتَّى بينها وبين بعضها, ولهذا انتهى بهما المطاف إلى دارٍ للمُسنّين, لكلٍّ منهما غرفةٌ منفصلةٌ, وكلٌّ منهما يقطع النَّهار في حلِّ الكلمات المتقاطعة, وشُرب النبيذ, والاستماع إلى التّلفزيون ومشاهدته, وهذا شأن الكبار هنا حين يتقدَّم بهم السن.
قال الرَّجل الريفيّ في استغراب:
– والصغار.
– بعد السابعة عشرة يذهب كلُّ واحدٍ وشأنه, لي ثلاثة إخوةٍ, وأختٌ رابعة, تفرَّقوا في القارات الخمسة, وتفرَّقت بهم
المصائر, الأخ الأكبر تزوَّج من امرأة بوذيةٍ في كمبوديا، والأصغر قُطعت ساقه في حادث, وهو يعمل بارمان في كَلكُتا، والأخ الأوسط يشتغل في مصنع سلاحٍ في جنوب أفريقيا, أمَّا الأخت فقد تزوَّجت من فيتنامي ولم تنجب, ثمّ افترقت عن زوجها, وأنجبت ولداً تُكرِّس له الآن كلَّ وقتها, وتعمل مدرِّسة بيانو.
– وزوجها.
– إنَّها لم تتزوَّج بعد الفيتنامي, لقد أنجبت ولداً بعد قصّة حب، وكما تعلم هذه الثورات العاطفية تنتهي إلى لا شيءٍ وتبدأ المشاكل, وهذه مسائل عاديَّةٌ تحدث الآن كثيراً.
– ألا تلتقون؟
– عَبْرَ بطاقات الكريسماس, وهدايا عيد الميلاد كلّ عام.
ودخل الكلب, وكانت حول بطنه ضمادة.
واحتضنه الدكتور كرافت في حنانٍ بالغ, وراح يربِّت على رأسه ويقبّله.
– المسكين, عملنا له بالأمس رسم قلبٍ كهربائيّ, وفحصاً بالأشعّة, وبالأمواج فوق الصوتية, واتَّضح أنَّ عنده ورمٌ سرطاني, وقام الجرَّاح منذ أسبوعٍ باستئصال الورم بنجاح, صدّقني لقد حزنت من أجله كثيراً, ولم أذق طعم النوم منذ أيام.
قال الرَّجل الريفيّ وهو يقلِّب كفَّيه في عجب:
– هذا شيءٌ مؤسفٌ فعلاً, هذا قدره.
وراح الدكتور يسأل صاحبنا ماذا يعني بكلمة القدر, وقال إنَّه سمع الشَّرقيين يتحدَّثون كثيراً عن القدر, ويُلاحظ أنَّهم يدسُّون هذه الكلمة في كلِّ شيء, وها أنت تدسُّها حتَّى في شئون الكلاب, صدِّقني أنا لا أفهم.
وأخذ الرَّجل الرِّيفيّ يتكلّم بإسهابٍ عن الإيمان بالله وبالقدر, وأنَّ الله بيده ناصية كلِّ الخلق, وما من دابَّةٍ إلَّا هو آخذ بناصيتها, سواء كانت بهيمةً أو كلبا أو حشرة, وأنَّه ما من ورقة تسقط إلّا يعلمها, وما من رطبٍ ولا يابسٍ إلَّا عنده في کتاب.
وقال الدكتور شاخت في براءةٍ «شديدة»:
– ولكن أين هو؟
– من؟
– الله الذي تقول.
فسكت الرَّجل الرّيفيّ, وانعقد لسانه دهشةً من السؤال الفجائي، ثمَّ عاد يقول ببطء:
– الله لا يقال عنه: متى ولا أين, لأنَّه هو الذي خلق متى وأين, هو الذي خلق الزَّمان والمكان, ولا يخضع لها كما تخضع. هو فوق الأين.
فبدا على الدُّكتور شاخت أنَّه لا يفهم، ولكنَّه قال في احترامٍ شديد:
– ألا يمكن أن نتكلَّم كلاماً أكثر وضوحاً وواقعيّة, ألا يمكن أن تقول لي عن الله شيئاً ملموساً, صدّقني أنّي في دهشة من إيمانكم العميق أيُّها المصريّون, إيمانٌ بطول سبعة آلاف سنة, إنَّه شيءٌ عجيبٌ يُدهشني, منذ سبعة آلاف سنةٍ وأنتم تبنون للموت ولا تعيشون للحياة، ولكن لما بعد الحياة, وكأنَّما، أنتم متأكدون تماماً من كلِّ شيءٍ, ألا يُدهشك هذا؟ من أين لكم بهذا اليقين, بأنَّ بعد الموت شيئاً لكم, أتمنَّى أن أرى الله كما ترونه»
فقال الرّجل الرّيفيّ ببساطة:
– إنّي لا أرى غيره, أراه في تفتُّح الزَّهرة, وابتسامة الوليد, وأراه في الصواعق, وأرى مشيئته في حركة التَّاريخ، وأرى يده في قبضة الجاذبية التي تضمُّ شمل الكون وتمسك بالمجرَّات وتحمل السَّموات بلا عمد, وأراه أقرب إليَّ من نفسي بل أقرب إليَّ من نُطقي، وأراه في العماء خلف كلِّ شيءٍ, في غيب الغيب, لا يُوصف ولا يُحدّ, سبحانه ليس كمثله شيء.
وحاول أن يبحث عن كلمات تقول أكثر, وتُفصح أكثر, وتُجسّد أكثر, كلماتٍ يعبر بها الفجوة الهائلة بينه وبين محدِّثه ولكن لم يجد.
كانت الفجوة كبيرةً, فجوةً بين حضارتين.
حضارة لا تؤمن إلَّا بما ترى وتلمس وتحسّ وتسمع.
حضارة مادّيّة تبدأ من المادَّة, وتنتهي إلى المادّة, وتُشيد من المادّة معجزاتٍ, وخوارق, واختراعاتٍ, وسفن فضائية, وقنابل, وتصنع بها الدَّمار والعمار.
وحضارة أخرى توَّاقةٍ حالمة, منقطعة إلى الغيب تتصنَّت بالقلب والرّوح على مالا يُرى وما لا يُسمع, وتعبر المادة أبداً ودائماً إلى ما وراءها.
وسكت الرَّجل الرّيفيّ ولم يجد كلاماً يقوله ليعبُر به الفجوة, وأخذ يُعيد ما قال, وكأنَّما يخاطب نفسه.
– إنِّي لا أرى غيره, لا أرى إلَّا الله, سبحانه لا سواه.
قال الدكتور كرافت:
– إنّي لا أملك إلَّا أن أحترمك, ولكنِّي لا أفهمك.
وفي ذلك المساء كان الرَّجل الرِّيفيُّ يحدِّث زوجته, وهو يخبط كفَّاً بكفّ:
– أرأيتِ, إنَّه لا توجد أسرة, لقد انفرط كلُّ شيء, البنت تحمل سِفاحاً، والإخوة تفرَّقوا في أركان الأرض ليواجه كلٌّ منهم مصيره بلا عونٍ وبلا سند، والأب والأم منبوذان يعيشان وحيدين في دارٍ للمسنِّين, ولم يبق إلَّا الكلب, أقاموه صنماً بديلاً يبذلون له الودّ والحبّ والحنان والعبادة التي خلت منها الحياة, ويحاولون أن يخلقوا بالمعنى والحكمة التي سلبوها كلّ شيء, إنَّ كلَّ ما تشاهدينه في الفندق من تحيَّاتٍ ومُجاملاتٍ وآدابٍ, مائدة, وسلوك مهذّب, ولياقة, كلُّها تعبيراتٌ فارغة لا تدلُّ على شيءٍ ولا تحتوي على مضمون, إنَّها مجرَّد حياةٍ تلهث وراء مُتَعٍ لحظيَّة, ثمّ موتٌ, ثمَّ ترابٌ, ثمَّ عدمٌ, ثمَّ معنى ولا حكمة, وإنَّما عبث, ولم يعجب زوجتَه الكلام وأعطته ظهرها, وقالت كالعادة:
– لا تتعجَّل في الحكم, ولا تستخرج حكماً عامَّاً من لقاءٍ عابر, انظر حولك, إنَّك في عالمٍ كعرائس الخيال, أبَّهةٌ ونظافةٌ, وأناقةٌ, وجمالٌ, وعلمٌ, وصناعة.
قال بهدوء وقد أعطاها ظهره هو الآخر:
– كلُّ هذا يمكن أن ينهدم في لحظة, حينها تنهدم القيم التي تمسك به.
كلُّ هذا يُصبح مثل النَّقش على الماء:
قالت في مرارة.
– وهل عندنا في مصر قِيَم, هل عندنا أخلاق؟
– صحيح لقد أصابت عدوى الانحلال الكثيرين في بلادنا, وصحيحٌ عندنا فساد, ولكن مازال عندنا أولو بقيةٍ من أهل الخير, يعرفون الله, ويأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر, ويقومون الليل, ويسبِّحون النَّهار, وهؤلاء هم عُمُدُ الأرض, وأركان الدنيا, يحفظ الله الدنيا من أجلهم, وبدونهم لا يعود لها بقاء.
قالت وهي مازالت تنظر غرباً, وقد أعطته ظهرها.
– بل أركان الدُّنيا هنا, ولكنَّك ترفض أن تراها, وأعمدة الحياة حولك ولكنَّك تُنكرها, وناطحات السَّحاب تنطح السَّماء, وتصنع الأقدار للألوف, والعقول الإلكترونيّة تدبّر المصائر للملايين، وما نسميه انحلال الأسرة هو روح الحرية, والمغامرة, ولكنَّك لا تريد أن ترى, ولا تريد أن تُغيّر من نفسك شيئاً.
قال وهو مازال يعطيها ظهره وينظر شرقاً.
– نسيتِ أنَّ صانع كلِّ هذا العمار, ترك نفسه خراباً, وأنَّه يوشك أن ينتحر ويقتل نفسه بما صنع, وأنَّ عُمُدَ الدنيا في نظرك وأركان الأرض يوشكون أن ينقضُّوا على بعضهم البعض بالأسلحة الذّرّية والقنابل النووية, وأنَّهم لوَّثوا مِن حولِهم الفضاء والماء والهواء, كما لوَّثوا عقولهم بالخمور والمخدّرات، ولوَّثوا أرواحهم بالكفر والجحود, وأنَّ ما ترينه برَّاقاً حولك هو الغرور ومتاع الغرور, وخيال اللحظة, ونشوة اللمحة البارقة, واقرئي التاريخ, وانظري خلفك, بل تحت قدميك, بل في التراب تحتك, حيث اندثرت أممٌ وامبراطوريات, وحيث انتهى عماليق طاولوا الشَّمس وخرقوا السماء.
ولكنَّها لم تنظر إلى وراء، ولم تلتفت إلى التراب تحت قدميها, وإنَّما ظلَّت ناظرةً مبهورةً دائماً إلى الغرب, على حين ظلَّ هو شاخصاً إلى الشرق, إلى مطلع الأنوار, وقد أعطى كلٌّ منهم ظهره للآخر, وبينهما خيطٌ رفيعٌ, رفيعُ, هو عقد زواج يوشك أن ينقطع.
***
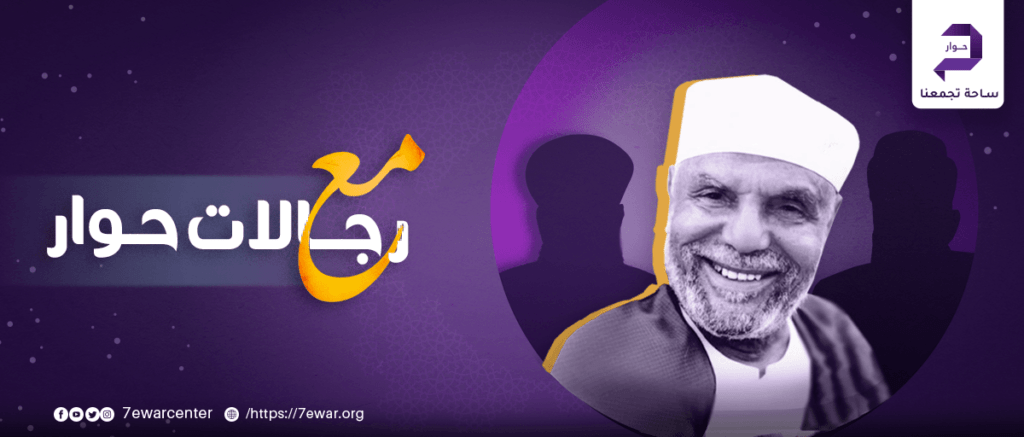
![]()









