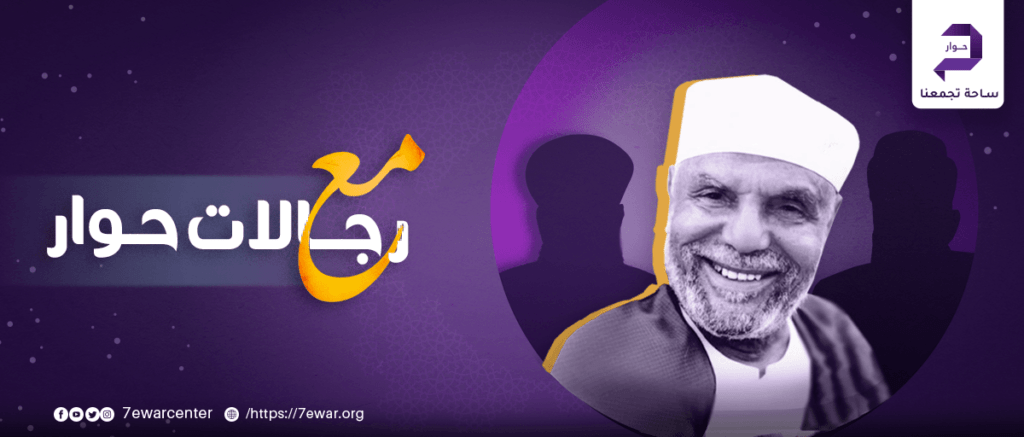هل الدين أفيون
![]()
هل الدين أفيون
قال لي صاحبي الدكتور وهو يغمز بعينيه :ما رأيك في الذين يقولون أن الدين أفيون وأنه يخدر الفقراء والمظلومين ليناموا على ظلمهم وفقرهم ويحلموا بالجنة والحور العين.
بينما يثبت الأغنياء على غناهم باعتبار أنه حق وأن الله خلق الناس درجات؟
وما رأيك في الذين يقولون أن الدّين لم ينزل من عند الله وإنما طلع من الأرض من الظروف والدواعي الاجتماعية ليكون سلاحاً لطبقة على طبقة؟ وهو يشير بذلك الى الماديين وأفكارهم. قلت: ليس أبعد من الخطأ القائل بأن الدين أفيون.. فالدين في حقيقته أعباء وتكاليف وتبعات وليس تخففاً وتحللاً وبالتالي ليس مهرباً من المسؤوليات وليس أفيوناً وديننا عمل وليس كسلاً .
((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ )) [١٠٥ – التوبة]
ونحن نقول بالتوكل وليس بالتواكل. والتوكل يقتضي عندنا العزم واستفراغ الوسع وبذل غاية الطاقة والحيلة ثم التسليم بعد ذلك لقضاء الله وحكمه.
((فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)) [١٥٩ – آل عمران]
العزم أولاً والنبي يقول لمن يريد أن يترك ناقته سائبة توكلاً على حفظ الله (اعقلها وتوكل…) أي ابذل وسعك أولاً فثبتها في عقالها ثم توكل والدين صحو وانتباه ويقظة ومحاسبة للنفس ومراقبة للضمير في كل فعل وفي كل كلمة وكل خاطر وليس هذا حال آكل الأفيون.
إنما آكل الافيون الحقيقي هو المادي الذي ينكر الذين هرباً من تبعاته ومسؤولياته ويتصور أن لحظته ملكه وانه لا حسيب ولا رقيب ولا بعث بعد الموت فيفعل ما يخطر على باله. وأين هذا الرجل من المتدين المسلم الذي يعتبر نفسه مسؤولاً عن سابع جار.. وإذا جاع فرد في أمته أو ضربت دابة عاتب نفسه بأنه لم يقم بواجب الدين في عنقه وليس صحيحاً أن ديننا خرج من الأرض. من الظروف والدواعي الاجتماعية ليكون سلاحاً لطبقة على طبقة وتثبيتاً لغنى الأغنياء وفقر الفقراء.
والعكس هو الصحيح.. فالإسلام جاء ثورة على الأغنياء والكانزين المال والمستغلين والظالمين.
فأمر صراحةً بأن لا يكون المال دولة بين الأغنياء يحتكرونه ويتداولونه بينهم وإنَّما يكون حقَّاً للكل: ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)) [التوبة-34]. والإنفاق يبدأ من زكاةٍ إجباريةٍ 2.5 في المئة ثمَّ يتصاعد اختيارياً إلى كلِّ ما في الجيب؛ وكلِّ ما في اليد فلا تُبقي لنفسك إلَّا خبزك كفافك: ((وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ)) [البقرة-219].
والعفو: هو كلُّ ما زاد عن الكفاف والحاجة، وبهذا جمع الإسلام بين التكليف الجبريِّ القانونيّ، والتكليف الاختياري القائم على الضمير، وهذا أكرم للإنسان من نزع أملاكه بالقهر والمصادرة، ووصل بالإنفاق إلى ما فوق التسعين في المئة دون إرهاق.
ولم يأت الإسلام ليثبِّت ظلم الظالمين بل جاء ثورةً صريحةً على كلِّ الظالمين، وجاء سيفاً وحرباً على رقاب الطواغيت والمستبدِّين.
أمَّا التهمة التي يسوقها المادِّيون بأنَّ الدِّين رجعيٌّ وطبَقيٌّ بدليل الآيات :((وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ)) [النحل-71]. ((وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ)) [الزخرف-32].
فنحن نردُّ بأنَّ هذه الآيات تنطبق على لندن وباريس وبرلين وموسكو بمثل ما تنطبق على القاهرة ودمشق وجدَّة، وإذا مشينا في شوارع موسكو فسوف نجد من يسير على رجليه، ومن يركب (بسكليت)، ومن يركب عربة موسكو فتش، ومن يركب عربة زيم فاخرة، وماذا يكون هذا إلَّا التفاضل في الرزق بعينه، والدرجات والرتب الاقتصادية. والتفاوت بين الناس حقيقةٌ جوهريةٌ، ولم تستطع الشيوعية أن تُلغي التفاوت، ولم يقُل حتَّى غُلاة المادية والفوضوية بالمساواة، والمساواة غير ممكنة؛ فكيف نساوي بين غير متساويين.
الناس يُولدون من لحظة الميلاد غير متساوين في الذكاء، والقوَّة، والجمال، والمواهب، يولدون على درجاتٍ في كلِّ شيءٍ.
وأقصى ما طمعت فيه المذاهب الاقتصادية هي المساواة في الفُرَص. وليست المساواة بين الناس أن يلقى كلُّ واحدٍ نفس الفرصة في التعليم والعلاج، والحدِّ الأدنى للمعيشة، وهو نفس ما تحضُّ عليه الأديان، أمَّا إلغاء الدرجات، وإلغاء التفاوت فهو الظلم بعينه، والأمر الذي يُنافي الطبيعة، والطبيعة تقوم كلُّها على أساس التفاضل، والتفاوُت، والتنوُّع في ثمار الأرض، وفي البهائم، وفي الناس .
في القطن: نجد طويل التِّيلة، وقصير التِّيلة، وجيزة7، وسكلاريدس، وفولي جود فير.
في البلح: مجد الزغلول، والسماتي، والحياني،
وفي العنب: تجد البناتي، والفيومي، والأزمرلي،
وفي الحيوان والإنسان نجد الرُّتَب والدرجات والتفاوت أكثر.
هذا هو قانون الوجود كلّه التفاضل، وحكمة هذا القانون واضحةٌ؛ فلو كان جميع الناس يولدون لما كان هناك داعٍ لخلقةٍ واحدةٍ وقالبٍ واحدٍ، ونسخةٍ واحدةٍ لميلادهم أصلاً، وكان يكفي أن تأتي نسخةٌ واحدةٌ فتغني عن الكلِّ، وكذلك الحال في كلِّ شيء، ولانتهى الأمر إلى فقر الطبيعة وإفلاسها، وإنَّما غِنى الطبيعة وخصبُها لا يظهر إلَّا بالتنويع في ثمارها وغلَّاتها، والتفاوت في ثمارها،
ومع ذلك فالدِّين لم يسكت على هذا التفاوت بين الأغنياء والفقراء بل أمَر بتصحيح الأوضاع، وجعل للفقير نصيباً في مال الغني، وقال: إنَّ هذا التفاوُت فتنةٌ وامتحان: ((وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ)) [الفرقان-20].
سوف نرى ماذا يفعل القوي بقوَّته، هل يُنجد بها الضعفاء؛ أم يضرب ويقتل ويكون جبَّاراً في الأرض، وسوف نرى ماذا يفعل الغنيُّ بغناه؛ هل يطغى ويُسرف؛ أم يعطف ويُحسن؟ وسوف نرى ماذا يفعل الفقير بفقره، هل يحسد ويحقد ويسرق ويختلس… أم يعمل ويكدُّ ويجتهد ليرفع مستوى معيشته بالشرع والعدل؟
وقد أمر الدِّين بالعدل، وبتصحيح الأوضاع، وبالمساواة بين الفرص، وهدَّد بعذاب الآخرة، وقال بأنَّ الآخرة ستكون أيضاً درجات أكثر تفاوُتاً لتصحيح ما لم يجر تصحيحه في الأرض: ((وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً)) [الإسراء-21].
وللَّذين يتَّهمون الإسلام بالرجعية السياسية، ونقول أنَّ الإسلام أتى بأكثر الشرائع تقدُّميَّة في نظم الحكم، واحترام الفرد في الإسلام بلغ الذروة، وسبق ميثاق حقوق الإنسان وتفوَّق عليه، فماذا يساوي الفرد الواحد في الإسلام؟ إنَّه يُساوي الإنسانية كلَّها:
((مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)) [المائدة-32].
لا تُغني المنجزات، ولا الإصلاحات المادّية، ولا التعمير، ولا السدود، ولا المصانع إذا قتل الحاكم فرداً واحداً ظُلماً في سبيل هذا الإصلاح، فإنَّه يكون قد قتل الناس جميعاً. ذروةٌ في احترام الفرد لم يصل إليها مذهبٌ سياسيٌّ قديمٌ أو جديد، فالفرد في الإسلام له قيمةٌ مطلقةٌ بينما في كلِّ المذاهب السياسية له قيمةٌ نسبية،
والفرد في الإسلام آمِنٌ في بيته، وفي أسراره، ولا تجسُّس، ولا غيبة، آمِنٌ في ماله ورزقه وملكيَّته وحرِّيَّته، وكلِّ شيء، حتَّى التحية، حتَّى إفساح المجلس، حتَّى الكلمة الطيبة لها مكانٌ في القرآن، وقد نهى القرآن عن التجبُّر والطغيان والانفراد بالحكم.
وقال الله للنَّبيِّ وهو من هو في كماله وصلاحيَّاته: ((وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ)) [ق-45]، ((فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ* لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ)) [الغاشية-21]. ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)) [الحجرات-10]، ونهى عن عبادة الحاكم، وتأليهِ العظيم: ((وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّه)) [آل عمران-64]، ((وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)) [الإسراء-23].
ونهى عن الغوغائية، وتملُّق الدهماء والسوقة، والجري وراء الأغلبية المضلِّلة، وقال: ((وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)) [يوسف-40]، ((بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)) [العنكبوت-63]، ((ولكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ)) [غافر-59]، ((إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)) [الأنعام-116]، ((إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً)) [الفرقان-44]. ونهى عن العنصرية والعرقية: ((إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)) [الحجرات-13]، ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ)) [الأعراف-189]. وبالمعنى العلمي؛ كان الإسلام تركيباً جدلياً جامعاً بين مادِّية اليهودية وروحانية المسيحية، بين العدل الصارم الجاف الذي يقول: السنُّ بالسنِّ والعين بالعين، وبين المحبَّة والتسامح المتطرِّف الذي يقول: من ضربك على خدِّك الأيمن فأدر له الأيسر .
وجاء القرآن وسطاً بين التوراة التي حُرِّفت حتَّى أصبحت كتاباً مادِّياً ليس فيه حرفٌ واحدٌ عن الآخرة، وبين الإنجيل الذي مال إلى رهبانيةٍ تامَّة، ونادى القرآن بناموس الرحمة الجامع بين العدل والمحبَّة؛ فقال بشرعية الدفاع عن النفس، ولكنَّه فضَّل العفو والصفح والمغفرة: ((وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)) [الشورى-43]. وإذا كانت الرأسمالية أطلقت للفرد حرية الكسب إلى درجة استغلال الآخرين، وإذا كانت الشيوعية سحقت هذه الحرية تماماً؛ فإنَّ الإسلام قدَّم الحل الوسط:
((لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ)) [النساء-32]. الفرد حرٌّ في الكسب ولكن ليس له أن يأخذ ثمرة أرباحه كلَّها؛ وإنَّما له فيها نصيب، وللفقير نصيبٌ يؤخذ زكاةً وإنفاقاً 2.5 بالمئة جبراً لا اختياراً، وهذا النصيب ليس تصدُّقاً وتفضُّلاً وإنَّما هو حقُّ الله تعالى في الربح، وبهذه المعادلة الجميلة حفظ الإسلام للفرد حُرِّيته وللفقير حقَّه، ولهذا أصاب القرآن كلَّ الصواب حين خاطب أُمَّة الإسلام قائلاً: ((كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)) [البقرة-143] .فقد اختار الإسلام الوسط العدل في كلِّ شيء، وهو ليس الوسط الحسابي وإنَّما الوسط الجدليَّ أو التركيب الذي يجمع النقيضين (اليمين واليسار) ويتجاوزهما ويزيد عليهما، ولذلك ليس في الإسلام يمينٌ ويسار وإنَّما فيه: صراط الاعتدال الوسط الذي نسمِّيه الصراط المستقيم، ومن خرج عنه باليمين أو اليسار فقد انحرف، ولم يقيِّدنا القرآن بدستورٍ سياسيٍّ محدَّدٍ أو منهج مفصَّل للحكم لعلم الله بأنَّ الظروف تتغيَّر بما يقتضي الاجتهاد في وضع دساتير متغيِّرة في الأزمنة المتغيِّرة، وحتَّى يكون الباب مفتوحاً أمام المسلمين للأخذ والعطاء من المعارف المتاحة في كلِّ عصرٍ دون انغلاقٍ على دستورٍ بعينه؛ ولهذا اكتفى القرآن بهذه التوصيات السياسيَّة العامَّة السالفة کخصائص للحكم الأمثل؛ ولم يكبِّلنا بنظرية، وهذا سرٌّ من أسرار إعجازه وتفوُّقه؛ وليس فقرٌ ولا نقصٌ فيه، وتلك لمسةٌ أُخرى من تقدُّمية القرآن التي سبقت على التقدُّميات. ونردُّ على القائلين بأنَّ الدِّين جمودٌ وتحجُّرٌ بأن الإسلام لم يكن أبداً دين تجمُّدٍ وتحجُّر وإنَّما كان دائماً وأبداً دين نظرٍ، وفكرٍ، وتطويرٍ، وتغييرٍ بدليل آياته الصريحة: ((قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ)) [العنكبوت-20]، ((فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ)) [الطارق-7]،
((أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)) [الغاشية-9]، أوامر صريحةٌ بالنظر في خلق الإنسان، وفي خلق الحيوان، وفي خلق الجبال، وفي طبقات الأرض، وفي السماء وأفلاكها، وهي نظراتٌ تضمُّ كلَّ ما نعنيه الآن بعلم الجيولوجيا، والفلك، والتشريح، والفسيولوجيا، والبيولوجيا، وعلم الأجنّة، أوامر صريحةٌ بالسير في الأرض، وجمع الشواهد، واستنباط الأحكام والقوانين، ومعرفة كيف بدأ الخلق، وهو ما نعرِّفه الآن بعلوم التطوّر. ولا خوف من الخطأ فالإسلام يكافئ الذي يجتهد ويخطئ بأجر، والذي يجتهد ويصيب بأجرين.
. وليس صحيحاً ما يقال من أنَّنا تخلَّفنا بالدِّين وتقدَّم الغرب بالإلحاد، والحقُّ أنَّنا تخلَّفنا حينما هجرنا أوامر ديننا، وحينما كان المسلمون يأتمرون بهذه الآيات حقَّاً كان هناك تقدُّمٌ، وكانت هناك دولةٌ من المحيط الى الخليج، وعلماء مثل ابن سينا في الطبِّ، وابن رشد في الفلسفة، وابن الهيثم في الرياضيات، وابن النفيس في التشريح، وجابر بن حيَّان في الكيمياء، وكانت الدنيا تأخذ عنَّا علومنا.
وما زالت مجمعات النجوم وأبراجها تحتفظ إلى الآن بأسمائها العربية في المعاجم الأوروبية، ومازالوا يسمُّون جهاز التقطير بالفرنسية imbique ومنه الفعل من كلمة أمبيق العربية imbiquer، ولم يتقدَّم الغرب بالإلحاد بل بالعلم، وإنَّما وقع الخلط عمَّا حدث في العصور الوسطى من طُغيان الكنيسة ومحاكم التفتيش وحجرِها على العلم والعلماء، وما حدث من سجن غاليليو، وحرق جيوردانو برونو حينما حكمت الكنيسة وانحرف بها البابوات عن أهدافها النبيلة فكانت عنصر تأخُّرٍ فتصوَّر النُّقَّاد السطحيون أنَّ هذا ينسحب أيضاً على الإسلام وهو خطأ، فالإسلام ليس فيه بابوية ولا كهنوت، والله لم يُقِم بينه وبين المسلمين أوصياء ولا وسطاء، وحينما حكم الإسلام بالفعل كان عنصرَ تقدُّمٍ كما شرحنا وكما يقول التاريخ مكذِّباً هذه المزاعم السطحية.
وآيات القرآن الصريحة تحضُّ على العلم، وتأمر بالعلم، ولا تُقيم بين العلم والدين أيَّ تناقض :((وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً)) [طه-114]، ((هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)) [الزمر-9]، ((شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ)) [آل عمران-18]. جعل الله الملائكة وأولي العلم في الآية مقترنين بشرف اسمه ونسبته، وأوَّل آيةٍ في القرآن وأوَّل كلمةٍ كانت (اقرأ)، والعلماء في القرآن موعودون بأرفع الدرجات: ((يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)) [المجادلة-11].
وتتكرَّر كلمة العلم ومشتقَّاته في القرآن ثمانمئة وخمسين مرَّة، فكيف يتكلَّم بعد هذا متكلِّمٌ عن تناقضٍ بين الدِّين والعلم؛ أو حجْرٍ
من الدِّين على العلم. والنظر في الدِّين وتطوير فهمه مطلوب،
وتاريخ الإسلام كلُّه حركاتٌ وتطوير، والقرآن بريءٌ من تهمة التحجير على الناس، وكلُّ شيءٍ في ديننا يقبل التطوير ما عدا جوهر العقيدة، وصلب الشريعة لأنَّ الله واحدٌ؛ ولن يتطوَّر إلى اثنين أو ثلاثة وهذا أمرٌ مطلق، وكذلك الشرُّ شرٌّ، والخير خيرٌ ولن يُصبح القتل فضيلةً، ولا السرقة حسنة، ولا الكذب حليةً يتحلَّى بها الصالحون . وفيما عدا ذلك فالدِّين مفتوحٌ للفكر والاجتهاد والإضافة والتطوير .وجوهر الإسلام عقلانيٌّ منطقيٌّ يقبل الجدل والحوار ويحضُّ على استخدام العقل والمنطق وفي أكثر من مكانٍ وفي أكثر من صفحةٍ في القرآن تعثر على التساؤل: ((أَفَلَا يَعْقِلُونَ))، ((أَفَلَا يَفْقَهُونَ)).
وأهل الدِّين عندنا هم أولو الألباب: ((إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ)) [الأنفال-22]، ((أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا)) [الحج-46]. فاحترام العقل في لبِّ وصميم الديانة، والإيجابية عصبُها، والثورة روحها.
لم يكن الإسلام أبداً خانعاً ولا سلبياً: ((وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ)) [البقرة-190]، ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ)) [الصف-4]، والجهاد بالنفس والمال والأولاد، والقتال والثبات وعدم النكوص على الأعقاب، ومواجهة اليأس والمصابرة والمرابطة في صلب ديننا .فكيف يمكن لدينٍ بهذه المرونة، والعقلانية، والعلمية، والإيجابية، والثورة أن يُتَّهم بالتحجُّر والجمود إلَّا من صديقٍ عزيزٍ مثل الدكتور القادم من فرنسا لا يعرف من أوَّليات دينه شيئاً، ولم يقرأ في قرآنه حرفاً.