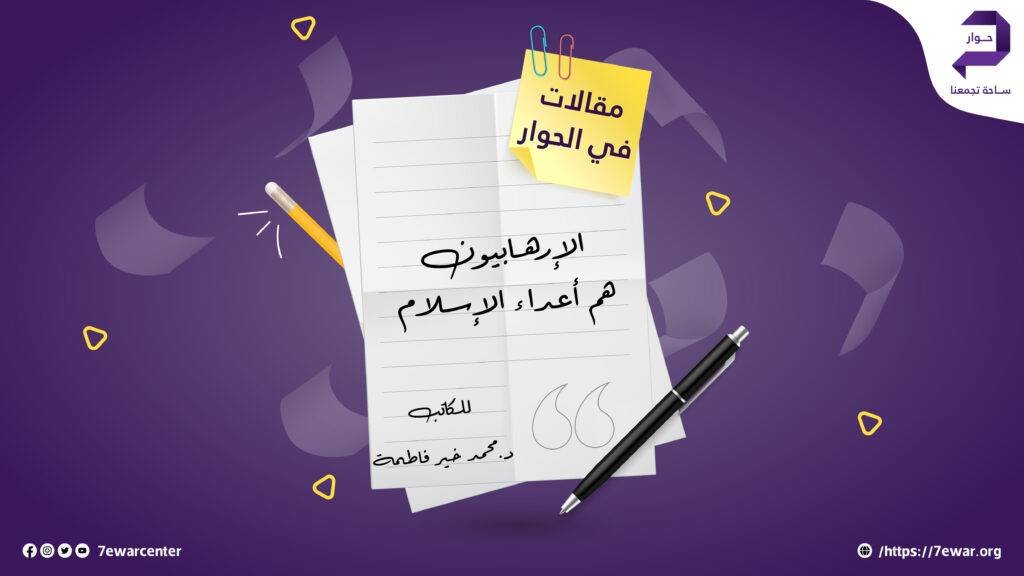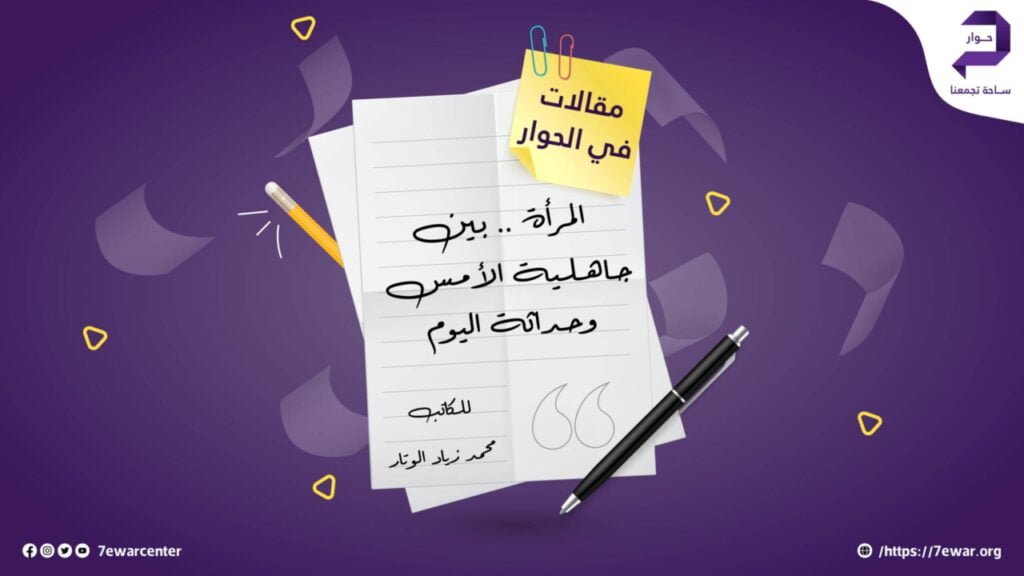ثمن الجنة
هل الدين أفيون
عن عائشة زوج النَّبيِّ ﷺ أنَّها كانت تقول: “سَدِّدُوا وقارِبُوا، وأَبْشِرُوا، فإنَّه لَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ أحَداً عَمَلُهُ”، قالوا: ولا أنْتَ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: “ولا أنا، إلَّا أنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ منه برَحْمَةٍ، واعْلَمُوا أنَّ أحَبَّ العَمَلِ إلى اللهِ أدْوَمُهُ وإنْ قَلَّ”. [صحيح مسلم]
هذا الحديث أصلٌ عظيمٌ, وقاعدةٌ جليلة؛ فعمل الإنسان مهما بلغ، ومهما كان في الحسن والإتقان, لا يؤهِّله بمجرَّده لدخول الجنة، ولا يُنجيه من النار، وإنَّما ذلك كلُّه يحصل بمغفرة الله ورحمته.
لكنَّ ربَّنا سبحانه قال :﴿ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ لَاْ خَوْفٌ عَلَيْكُم وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ﴾ [الأعراف49].
﴿وَنُوْدُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف43]، وَقَالَ جلَّ جلاله: ﴿كُلُوْا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الخَالِيَةِ﴾ [الحاقَّة 24] ، وَقَالَ : ﴿أَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلَاً بِمَا كَانُوا يَعْملُونَ﴾ [السَّجْدَة19]، وَقَالَ : ﴿وَحُوْرٌ عِيْنْ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ﴾ [الْوَاقِعَة23].
فكيف نجمع بين الحديث الذي ينفي دخول الجنَّة بالعمل، وبين الآيات التي تعتبر دخول الجنة بالعمل؟
الجواب :
لَا مناقضة بَين مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآن وَمَا جَاءَت بِهِ السُّنَّة؛ إِذْ الْمُثبَت فِي الْقُرْآن، لَيْسَ هُوَ الْمَنْفِيّ فِي السُّنَّة، والتناقض إِنَّمَا يكون إِذا كَانَ الْمُثبت هُوَ الْمَنْفِيّ. فالمنفيُّ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الجَنَّةَ) باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنَّة. كما زعمت المعتزلة أنَّ العامل مستحقٌّ دخول الجنَّة على ربِّه بعمله! بل ذلك برحمة الله تعالى وفضله، والباء التي في قوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وغيرها، باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسبّبات، فرجع الكلُّ إلى محض فضل الله ورحمته.
فبرحمة الله وعفوه سبحانه وتعالى، يحصل قبول العمل، ودخول الجنَّة والنجاة من النار، فهو الذي تفضَّل بالقوَّة على العمل، ويسَّر العمل وأعان عليه، فكلُّ خيرٍ منه سبحانه وتعالى. ثمَّ تفضَّل بإدخال العبد الجنَّة، وإنجائه من النار بأسباب أعماله الصالحة. فالمعوَّل على عفوه تعالى ورحمته، لا على عمل العبد، فعمل العبد لو شاء الله جلَّ وعلا لما كان، ولما وُفِّق إليه، فهو الذي وفَّقه له وهداه إليه، فله الشكر، وله الحمد جلَّ وعلا، ودخولهم الجنَّة برحمته وفضله ومغفرته، لا بمجرَّد أعمالهم، بل أعمالهم أسباب، والذي يسَّرها وأوجب دخول الجنَّة ومنّ بذلك هو الله وحده سبحانه وتعالى.
فقد بيَّن الله تعالى في نصُوص القرآن :
أَن الْعَمَل سَبَبٌ للثَّواب والرَّحمة والفضل الإلهيّ، فالْبَاء للسبب ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾، أو ﴿بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الخَالِيَة﴾، أو ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ﴾. وهذا كلُّه كَمَا فِي مثل قَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الْأَعْرَاف57]، وَقَوله: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الْبَقَرَة164]، وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يبين بِهِ الْأَسْبَاب، وَلَا ريب أَنَّ الْعَمَل الصَّالح سَبَبٌ لدُخُول الْجنَّة، وَالله قدَّر لعَبْدِهِ الْمُؤمن وجوب الْجنَّة، بِمَا يسَّره لَهُ من الْعَمَل الصَّالح، كَمَا قدَّر دُخُول النَّار لمن يدخلُهَا بِعَمَلِهِ السَّيِّء …
وَإِذا عرف أَنَّ الْبَاء هُنَا للسَّبب؛ فمعلومٌ أَن السَّبَب لَا يسْتَقلُّ بالحكم؛ فمجرَّد نزُول الْمَطَر لَيْسَ مُوجباً للنَّبات، بل لَا بُدَّ من أَن يخلق الله أموراً أُخْرَى، بأن يدْفَع عَنهُ الْآفَات، ويربِّيه بِالتُّرَابِ وَالشَّمْس وَالرِّيح، وَيدْفَع عَنهُ مَا يُفْسِدهُ …
أمَّا قَوْله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم: (لن يدْخل أحدٌ مِنْكُم الْجنَّة بِعَمَلِهِ، قَالُوا: وَلَا أَنْت يَا رَسُول الله؟ قَالَ: وَلَا أَنا؛ إِلَّا أَن يتغمَّدني الله برحمةٍ مِنْهُ وَفضل)، إِنَّهُ ذكره فِي سِيَاق أمره لَهُم بالاقتصاد، قَالَ: (سدِّدوا وقاربوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ أحداً مِنْكُم لن يدْخل الْجنَّة بِعَمَلِهِ)؛ يعني لا تُبالغوا في الأمر، وتزيَّدوا فيه ظنَّاً منكم أنَّ هذه المبالغة وهذه الزيادة هي وحدها بمجرَّدها التي تُحصِّلون بها الجنَّة والسعادة يوم القيامة.
فنفى بِهَذَا الحَدِيث مَا قد تتوهَّمه النُّفُوس من أَنَّ الْجَزَاء من الله عزَّ وجلَّ ليس على سَبِيل الْمُعَاوضَة والمقابلة، كالمعاوضات الَّتِي تكون بَين النَّاس فِي الدُّنْيَا، كالْأَجِير يعْمل لمن اسْتَأْجرهُ؛ فيعطيه أجره بِقدر عمله على طَرِيق الْمُعَاوضَة: “إِن زَاد، زاد أُجرتَه، وَإِن نقص، نقصت أجرتَه، وَله عَلَيْهِ أُجْرَة يَسْتَحِقُّهَا، كَمَا يسْتَحقُّ البَائِع الثّمن؛ فنفى صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم أَن يكون جَزَاء الله وثوابه على سَبِيل الْمُعَاوضَة والمقابلة والمعادلة”. [انتهى من “جامع الرسائل” (1/145) وما بعدها] .
فلَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ يَنَالُ الْإِنْسَانُ السَّعَادَةَ في الآخرة؛ بَلْ هِو سَبَبٌ؛ فقَوله تعالى: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)؛ هَذِهِ بَاءُ السَّبَبِ، أَيْ: بِسَبَبِ أَعْمَالِكُمْ .وَاَلَّذِي نَفَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “بَاءُ الْمُقَابَلَةِ”؛ كَمَا يُقَالُ: اشْتَرَيْت هَذَا بِهَذَا؛ فَبِعَفْوِهِ يَمْحُو السَّيِّئَاتِ وَبِرَحْمَتِهِ يَأْتِي بِالْخَيْرَاتِ وَبِفَضْلِهِ يُضَاعِفُ الْبَرَكَاتِ.” انتهى. [من “مجموع الفتاوى” (8/70) وينظر جواب السؤال رقم (115075)]
ثانيا: إذا فهم هذا الأصل، وتقرَّر عند العبد أنَّ شيئاً من عمله لا يبلِّغه الجنَّة على وجه الاستحقاق منه على ربِّه، والمطالبة به؛ فلا حرج عندئذٍ في إطلاق شيءٍ من العبارات التي تذكر أنَّ العمل: “عربون الجنة”، أو “ثمن الجنَّة”، ونحو ذلك، على وجه التجوُّز والتوسع في التعبير، على ما جرى به لسان العرب في مثل ذلك، بل تكاثرت نظائره في نصوص القرآن، وعبارات السلف .
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) [التوبة111] .
قال ابن كثير رحمه الله : “يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ عَاوَضَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، إِذْ بَذَلُوهَا فِي سَبِيلِهِ: بِالْجَنَّةِ، وَهَذَا مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، فَإِنَّهُ قَبِلَ الْعِوَضَ عَمَّا يَمْلِكُهُ بِمَا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُطِيعِينَ لَهُ” .
فالله سبحانه اشترى أنْفُساً هو خلقها، وأموالاً هو مالكها، وَلِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ: “بَايَعَهُمْ، فَأَغْلَى ثَمَنَهُمْ”. يعني: هل تعدل السلعة المباعة ما أعده الله تعالى مقابلَها من ثمنٍ عظيم؟ أو ليس ذلك منَّةٌ من الله وفضلٌ كبير؟ إنَّ الحياة والمال الذي نتعامل به هالكٌ يوماً ما لا محالة، أوَليس المشتري ربٌّ كريمٌ هو الذي وهب الحياة والمال ثمَّ أراد أن يشتريهما؟
حقَّاً لقد ربح البيع، ولقد أدرك فضلَه المؤمنون السابقون الأوَّلون، فعضُّوا على هذه الصفقة بالنواجذ، وقالوا: لا نقيل ولا نستقيل، فسمع الله مقالتهم، وعلم صدق نيَّاتهم، وقد بايعهم فأغلى ثمنهم.[“ابن كثير” (4/218)]
وفي سنن الترمذي من حديث أبي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الجَنَّةُ.) [الترمذي]
وفي مسند الإمام أحمد، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً، وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، فَمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ” فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ: بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي. فَفَعَلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي. قَالَ: ” فَاجْعَلْهَا لَصاحب الأرض، ففعل، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ” قَالَهَا مِرَارًا. قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَتْ: رَبِحَ الْبَيْعُ. أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا”.
يعني أنَّ سلعة الله غاليةٌ في مقابل هذا الثمن الفاني الذي يقدِّمه الإنسان، ولهذا الاستعمال نظائر كثيرةٌ على ألسنة العلماء :
قال الحسن البصري رحمه الله: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثَمَنُ الْجَنَّةِ) [رواه ابن أبي شيبة].
كلُّ هذا يعني أنَّ هذا الثمن الذي دفعه الإنسان المؤمن هو السبب الذي أوصله إلى رحمة الله وفضله ومغفرته
فيدخل الجنَّة به.
والحاصل :
أنَّه لا حرج في استعمال مثل هذه الأساليب، مع الاحتراز من الاعتقاد بأنَّ عملاً معيَّناً: هو ثمن الجنة
إذاً فدخول الجنة بفضل الله قولاً واحداً، لكنَّ فضل الله عزَّ وجلَّ لا يناله إلَّا من دفع الثمن، ألَّا وهو العمل.
فإذا دفعت الثمن، وظننت أنَّ هذا الثمن هو كلُّ شيءٍ، فعندئذٍ لن تصل إلى الجنة، ولن تبلغ الجنة إلَّا إذا تيقَّنت أنَّها بفضل الله. ولذلك كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، حاسماً حينما سأله الصحابة، (فقالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا.
فأنت حينما تعِد ابنك بهديةٍ إذا نجح، فهل بعد نجاحه ستأتي الهدية وحدها، أم أنَّك ستضطر لدفع القيمة المساوية لشرائها، فهذه الهدية لها ثمن، ولكن سبب إهداء هذه الهدية للابن هو النجاح فصار العمل سبباً وليس العمل سبباً كافياً لدخول الجنَّة، فالإنسان إذا عمل عملاً صالحاً واستقام على أمره، وظنَّ أنَّه استحقَّ الجنَّة استحقاقاً قطعياً، وأنَّه أخذها بجهده، وعرق جبينه، ومجاهدته لنفسه وهواه، فهذا خطأٌ كبير، وإذا ظنَّ أنَّ الجنَّة ليست بالعمل لكنَّها بالأمل أيضاً وقع في خطأ كبيرٍ.
فبعض الناس فهم فهماً مغلوطاً فلم يعمل واتَّكل على الأمل، وأخطر شيءٌ في حياة الإنسان أن يتَّكل على الأمل ويترك العمل، وبعضهم فهم أنَّ الجنَّة بالعمل فقط، فيكون بذلك استغنى عن الله عزَّ وجلَّ وعن رحمته وفضله؟
وفضل الله على عباده أوسع من أعمالهم، والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء ﴿لَايُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ فالله عزَّ وجلَّ هو الخالق، وله أن يتصرَّف في ملكه كما يريد، وكيفما يشاء.
فقد رأى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رجلاً يصلِّي طوال النهار، فقال عليه الصلاة والسلام: من ينفق عليك؟ قال: أخي، قال: “أخوك أعبَدُ منك”، النَّبيُّ الكريم يقول: (والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خيرٌ لي من اعتكاف شهرٍ في مسجدي هذا). فنحن ندخل الجنَّة برحمة الله، وليس مقابل العمل لأنَّ العمل لا يساوي نعمةً واحدةً من نعم الله، وإذا كنتم عاجزين عن إحصائها فأنتم عن شكرها أعجز.
ويروى أنَّ رجلاً كان يعيش في جزيرةٍ، فأنبت الله له شجرة رمَّانٍ، وأجرى له عيناً من الماء…
فكان يأكل الرمَّان، ويشرب من الماء، وعاش ستمئة عامٍ متفرِّغاً للعبادة، فلمَّا جاء موعد أجله قبضته الملائكة وهو ساجدٌ، فقال الله عزَّ وجلَّ: أدخلوا عبدي الجنَّة برحمتي، قال: أي ربِّ بل بعملي، فقال الله عزَّ وجلَّ، إنَّه لا يُظلم اليوم عندي أحد، ضعوا نعمة البصر في الميزان، وضعوا أمامها عبادة ستمئة عام، فرجحت نعمة البصر على عبادة ستمئة عام. فقال: خذوه إلى النار، فقال أي ربِّ برحمتك، أي ربِّ برحمتك. [رواه الحاكم].