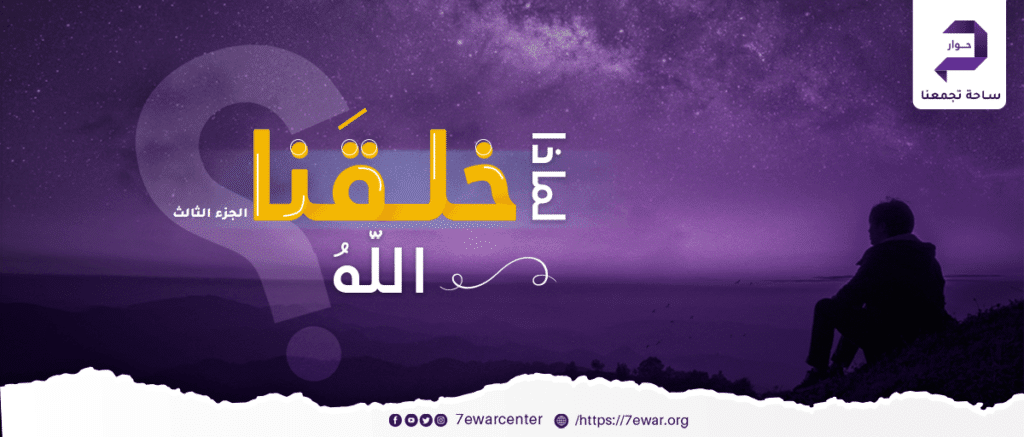
يتابع هذا الجزء المحطة الأخيرة من تساؤل الوجود والغاية من الخلق، فقد تمّت مناقشة التساؤلات الثلاث الأولى في المقالين السابقين، وهي:
- هل الله بحاجة لعبادتنا؟
- لماذا كلَّفنا بالأوامر الشرعية؟
- فماذا عن العبادات النُسُكية؟
وبقي لدينا السؤال الأبرز من هذه التساؤلات، وهو السؤال الرابع
فإذا كانت العبودية الخالصة حقاً لله على العباد فلماذا يخلقهم ابتداءً؟
ذكرنا في معرض الإجابة عن التساؤل الأوّل استغناءَ الله عن عبادةِ خلقه، وبطلانَ اعتقاد من يربط بين إرادة الله لشيءٍ وحاجته له، وتبيّن أنَّه لا حاجة لله في خلقه ولا يضرُّه شيءٌ منهم ولا ينفعهم، وهنا يبرز تساؤلٌ ملحٌّ في أذهان الكثيرين:
ما الحكمة من الخَلْقِ إذن؟
وقبل الإجابة التفصيلية عن ذلك يجب التوقف عند ثلاث نقاط مركزية:
النقطة الأولى:
لا يغيبنَّ عن أذهان الباحث عن الحكمة من الخلق مقامُه الأصليّ أوّلاً، وهو مقام العبودية والتسليم، ليقف السائل برجاءٍ وخشوعٍ. فالأصل أنَّ الله سبحانه لا يُسأل عن شيءٍ من فِعله، بل إنَّ العبيد هم الذين يُسألون، وهذا من تمام سلطانه على خلقه:
((سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)) [سورة الأنبياء : 22 – 23]
النقطة الثانية:
قبل الشُّروع في تلمُّس الحكمة من الخلق، على السائل أن يطرد من قلبه الوساوس والأوهام التي تتعلّق بهذا السؤال، حيث يعلم يقيناً أنَّ خلق السماوات والأرض حقٌّ لا لعبَ فيه ولا لهوَ ولا عبث، وقد بيّن القرآن الكريم ذلك في آياتٍ عديدةٍ منه، نقف على أبرزها،
حيث يقول جلَّ ذكرُه:
– ((وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ (17))) [سورة الأنبياء : 16 – 17].
– ((وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39))) [سورة الدخان : 38 – 39]
– ((تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّىۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ(3)﴾ [سورة الأحقاف : 2 – 3))
– ((أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116))) [سورة المؤمنون : 115 – 116]
يبيَّن الله سبحانه أنَّ خلق السماوات والأرض لم يكن عبَثاً بل ما كان إلا حقاً، وهذه الآيات يؤمن بها المسلم ويسلّم بما فيها إذا ما آمن بالقرآن وحياً من عند الله تعالى. ولمن أراد استئناساً عقلياً يعضد الأدلة القرآنية؛ فليطلق بصره تدبُّراً في خلق الله، ليعلم أنَّ خالقاً أحسنَ كلَّ شيءٍ خلقَهُ يستحيل في حقِّه أن يبدأ خلقَه لهواً أو يتركه عبثاً؛ ومن آمن بالله خالقاً حكيماً نزّهه عن كلِّ وصفٍ لا يليق. وهذا هو عين الأدب مع الله سبحانه.
النقطة الثالثة:
هناك علاقةٌ وطيدةٌ بين نُقصان العلم الإنساني والإشكالات التي تطرأ في أذهان الناس، فإذا توقَّفنا قليلاً عند سورة البقرة حيث ذُكرت قصّةُ الخلق الإنساني للمرَّة الأولى؛ نجد أنَّ القصّة بدأت بقول الله للملائكة: ((اني جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً))[ البقرة30]، ليتبعه السؤال الملائكي الأشهر: ((قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ)) [البقرة30]
، فيُعقِّب الله على تساؤلهم بقوله: ((إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَاْ تَعْلَمُوْنَ))[ البقرة30].
يقف المتسائل باحثاً عن العلاقة بين علم الله (الذي يعلم ما لا تعلمه الملائكة) وسؤال الملائكة نفسه!
والحقيقة أنَّ نقصان العلم لدى السائل يؤدي إلى نقصانٍ في إدراكه لبعض الأمور، وبالتالي يستشكل عليه فهم جزئياتٍ معيَّنةٍ لانعدام رؤية الصورة الكليّة. وهذا الأمر مقرّرٌ ومعروف بين المعلّمين والمربّين، فتداولت ألسنةُ الكثير منهم المقولة المشهورة: (من قلَّ علمُه كثُرَ اعتراضُه).
فلذلك على السائل أن يعيَ حقيقة نفسه ونقصان علمه قبل أن يسأل، وبذلك يمكن أن يردّ أي استشكال يجده في نفسه إلى نقصانه وقلّة إدراكه مقابل كمال الله وعلمه. [انظر تفصيل الحديث حول هذه المسألة في مقال “سؤال الملائكة” للمؤلف].
وبعد استعراض النقاط السابقة، يبرز التساؤل مجدداً:
نعم لقد سلّمنا أنَّه يجب على الإنسان أن يسأل بأدبٍ وخشوعٍ فالأصل: أنَّ الله لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وكذلك نزّهنا اللهَ سبحانه عن اللهو والعبث وذلك مقرَّرٌ في الشواهد القرآنية والقرائن العقلية، واتّضح لنا أنَّ أصل الاستشكال ناشئٌ عن قصور علمنا ونقصانه نحن البشر، ولكن يبدو إلى هذه اللحظة أنَّ تلكم الإجابات لم تروِ ظمأ السائل المتلهِّف، لماذا كان الخلقُ ابتداءً؟
وهنا يجدر التّوقف عند بعض الصفات الإلهية كي يتمكّن القارئ من إدراك تتمَّة المقال:
القدرة الصلوحية والقدرة التنجيزية:
يتَّصف الله سبحانه بصفاتٍ جليلةٍ كثيرةٍ، ومنها صفتا القدرة والإرادة؛ فالله سبحانه قادرٌ على كلِّ شيءٍ وهذا لا خلاف عليه بين المسلمين، وقد فصّلَ بعضُ علماء العقيدة في مراتب القدرة الإلهية فقالوا:
إنَّ الله قادرٌ على كلِّ شيءٍ وإنَّ الأحداث كلَّها تتمُّ بقدرة الله؛ فإذا وقع أيُّ حدثٍ سُمِّيت القدرة حينئذ بـ “القدرة التنجيزية” لأنَّ الفعل قد أُنجزَ وحدث، أمَّا إذا بقي معلَّقاً بإرادة الله سميت بـ “القدرة الصلوحية” والأمر صالحٌ لأن يحدث إذا أراد الله سبحانه.
فالقدرة الصلوحية: هي قدرة الله على فعل الأمر سواءً فعله أم لم يفعل، أمَّا القدرة التنجيزية: فهي إنجاز الله لقدرته وفقاً لإرادته. [للاستزادة انظر معنى الصلوحية والتنجيزية في متون عقيدة أهل السنة والجماعة]
تجدر الإشارة إلى أنَّ التصنيف السابق لمراتب القدرة الإلهية هو اصطلاحٌ تعارف عليه علماء أهل الكلام، وقد يعترض بعض القارئين على هذه الاصطلاحات ويظنُّها بدعةً في الدين لا أصل لها، والحقيقة أنَّ المعاني التي تقرُّها هذه المصطلحات معروفةٌ لدى جميع الناس، وما فعله هؤلاء العلماء هو إطلاق مصطلحٍ على كلِّ معنىً من هذه المعاني، ولا خلاف على المصطلحات إذ أنَّ المعنى معروفٌ بداهةً.
وبالعودة إلى سؤال الخلق، فمعلومٌ أنَّ خلق المخلوقات كان بقدرة الله تعالى، وأنَّ القدرة التنجيزية قد تمّت بخلق المخلوقات، فهو سبحانه قادرٌ على كلِّ شيءٍ، وتمَّت هذه القدرة بخلق كلِّ شيءٍ (تنجيزاً) كما أراد سبحانه، وذلك من تمام قدرة الله، وما الخلق إلا ثمرةٌ من ثمرات قدرته، وتجلياً من تجلِّيات عظمته.
والمتأمِّل في عالم المخلوقات من نجومٍ وأفلاكٍ ودوابٍّ وطيرٍ وحشراتٍ يجد هذه المسألة حاضرةً بجلاء، فيتأمّل الناظر كيف جعل الله سبحانه أنواعاً كثيرةً وألواناً شتّى وما ذلك إلا لعظيم قدرته، فخلق كلَّ شيء وقدَّره تقديراً.
جدير بالذكر أنَّ هناك من يقول بارتباط الله بمخلوقاته ارتباطاً للعلّةٍ بالمعلول دون إرادةٍ منه سبحانه، أي أنَّه يلزم على الله أن يخلق الخلقَ لأنَّه سببٌ والخلق نتيجتُه، لا يستطيع أن ينفكّ أحدهم عن الآخر؛ وهذا قول الفلاسفة الدهريين الذين ظهرت بدعتُهم في بداية العصر العباسيّ؛ حتى تصدَّى لهم فلاسفة المسلمين وأكّدوا الإرادة الإلهية، وأبطلوا قول الفلاسفة الذين يزعمون الخلق بلا إرادة.
أمَّا عن خلق الجنِّ والإنس فإنَّه سبحانه قد خَلَقَ كلَّ شيءٍ، وكان من هذه الأشياء خلقٌ مختارٌ ذو قدرةٍ على كسب أفعالٍ باختياره؛ فكان الجنُّ والإنس.
والأصل في هذا المخلوق أن يعترفَ بصفاته الأصيلة وضعفه الملازم فيتّبعَ الحقَّ ويعبُدَ اللهَ. ومن هنا يُفهم قول الله سبحانه: ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) [سورة الذاريات : 56] وأنَّ العبادة هي الأصل في المخلوق شاء ذلك أم أبى، (كما بيَّنا في إجابتنا على التساؤل الثالث “فماذا عن العبادات النُسُكية”).
وعليه فإنَّ “اللام” في قوله “ليعبدون” هي لأنَّ العبودية مرتبطةٌ بهم، ومتحصّلة من صفتهم الأصيلة “صفة المخلوقيّة”، ولا يُفهم من الآية أنَّ الله محتاجٌ لعبادة هؤلاء المخلوقات بل هو الغنيُّ الحميد.
فإذا ما أقام الجنّ والإنس العبودية لله كانوا منسجمين مع الكون المسخّر بأمر الله، وإلّا كانوا متمرِّدين على حقيقتهم حتى يعودوا إلى فطرتهم التي تستوجب منهم عبادة ربهم والاستجابة لأمره، حالُهم حالُ غيرهم من المخلوقات الذين خلقهم الله بقدرته الكاملة.
واللافت أنَّ لفظة “العبادة” المشار إليها في الآية السابقة تختلف عن “النُّسُك” الذي يظنُّ كثيرٌ من الناس أنَّ العبادة مقتصرةٌ عليه، فمفهوم العبادة أوسع من مفهوم “النُّسُك” بكثير؛ وهو بالمجمل الإذعان والانقياد لأوامر الله.
وعليه يُخطَّأ من يفهم من قوله: (إلا ليعبدون) أنَّ الله خلق الجنَّ والإنس للتَّنسُّك بين يديه سبحانه دون أداء حقوق الله في الدنيا، ويزداد الخطأ إن لم يُدرك السياق السابق، والذي يفهم على ضوئه المعنى المراد من الآية؛ فيُتوهم أنَّ الله أراد أن يمجِّده الناس لحاجةٍ فيه –سبحانه– فخلقهم وأمرهم بذلك، جلَّ وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. وقد بيّنّا تفصيل هذه المسألة في معرض الإجابة عن التساؤل الثالث (فماذا عن العبادات النُسُكية) في مثال المعلم الحكيم.
ومن هنا نعي أنَّ الله ما خلقنا لنقصٍ ولا لحاجةٍ يريدها سبحانه، وأنَّ الأصل في الإنسان أن يسبّح مع المخلوقات جميعاً مسلِّماً أمره لله سبحانه، فأمرَه بالعبادة إحقاقاً لهذا الأصل المرتبط ارتباطاً جوهرياً بمعنى المخلوقية، فلا مخلوق بلا افتقارٍ وعبادةٍ ولا خالقَ بلا غنىً وتمجيد.
ولذلك فإنَّ عبادة الله تعالى والخضوع له هي النظام الأصلي في الكون والفطرة السوية التي جبلت عليها الخليقة، أمّا الخروج عن عبادته وطاعته فذلك شذوذٌ عن الفطرة. وقد خلق الله سبحانه صنفين من الخَلْق؛ صنفاً جعلهم يسيرون مفطورين لا يخرجون عن فطرتهم وهم جميع المخلوقات عدا الإنس والجن، وصنفاً آخر أعطاهم الاختيار، وهم الجنّ والإنس، فمنهم من اختار عبادة الله وطاعته، ومنهم من خرج عن هذا القانون.
قال تعالى:
﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلۡجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌٞ مِّنَ ٱلنَّاسِۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيۡهِ ٱلۡعَذَابُۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ۩﴾ [سورة الحج : ١٨].
فمن خرج عن الطاعة فقد أهان نفسه لأنَّه شذَّ عن مخلوقات الله، لذا قال تعالى: ((وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ)) بعد ذكر إعراض الناس عن عبادته سبحانه.
يبيّن هذا المعنى د. سامي عامري بكلماتٍ بليغةٍ نختم بها هذه السلسلة، إذ يوضّح عبودية الإنسان وعلاقتها بالكون المحيط:
(إنَّ هذا الكون بأكملهِ ساجدٌ في محراب الطاعة خاضعٌ في محراب الناموس، فلا يخرج عن أمر الله القدري، قال تعالى: ((وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ)) [سورة الروم:26]، وقال سبحانه: ((أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)) [سورة آل عمران : 83]، وسجود الإنسان في محراب الطاعة الاختيارية يحقّق له التناغم مع هذا الكون السائر قهراً في طريق الخضوع للأمر الإلهي ويقيه الصدام مع الكون المتحرِّك معه)[د. سامي عامري – لماذا يطلب الله من البشر عبادته – صفحة 38]





No comment yet, add your voice below!